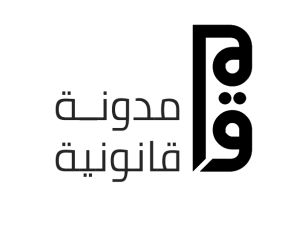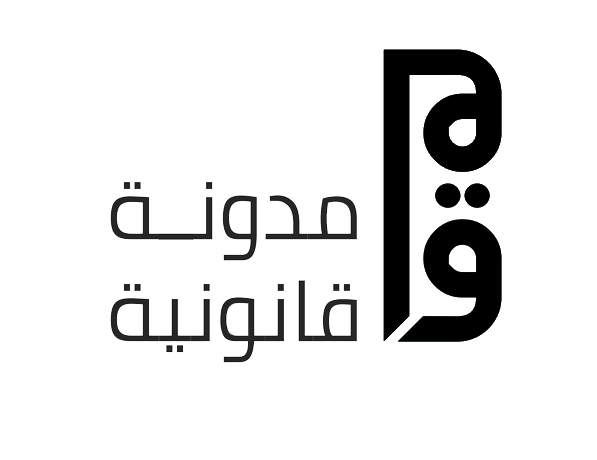إذا كان المقال السابق قد انتهى بنا إلى ضرورة استعادة التنظيم بوصفه “وعاء البقاء” وشرط الاستمرار الذي لا يمكن القفز فوقه، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال أكثر إلحاحاً وعمقاً: بأي مادة حيوية سنملأ هذا الوعاء؟ وما هي البوصلة التي ستمنع هذا الفعل الجماعي من أن يتحول إلى مجرد ارتطام عشوائي بجدران السلطة الصماء؟ الإجابة، برغم بساطتها الظاهرية، تكمن في “المعرفة“؛ لا بوصفها ترفاً أكاديمياً أو جمعاً بارداً للمعلومات في أرشيفات مغلقة بعيدة عن حياة الناس، بل بوصفها “فعل تحرر” وممارسة إجرائية مقاومة في زمن يُدار فيه المجتمع عبر سياسة ممنهجة ومنظمة لإنتاج الجهل. ففي سلسلة “التفكيك” السابقة، حللنا كيف تحولت المعلومة من حق طبيعي ودستوري إلى “سر سيادي“، وكيف أصبحت صناعة المجهول أداة مركزية للسيطرة، ومن هنا يصبح استرداد المعرفة هو الخطوة الأولى واللازمة لكسر الحصار الفكري والنفسي الذي استوطن وعينا قبل أن يستوطن واقعنا السياسي.
إننا نعيش في طور من أطوار السلطة لا يكتفي بمجرد منع الوصول إلى المعلومة أو فرض الرقابة التقليدية على الصحف والمواقع، بل يعمد إلى ما يمكن تسميته “هندسة العماء السياسي الشامل“. هذا العماء ليس نتاج صدفة إدارية أو قصور في الكوادر، بل هو استراتيجية حكم مدروسة تهدف إلى إبقاء الفرد والمجتمع في حالة ارتباك وجودي دائم، عاجزين عن رصد الأنماط المتكررة في سلوك السلطة أو فهم موازين القوى الحقيقية التي تحكم مصيرهم. فعندما يغيب الرقم الإحصائي الشفاف، وتُحجب ميزانيات المؤسسات العامة وشركات الدولة وراء ستار “الأمن القومي“، وتُغلق الأرشيفات في وجه الباحثين والمؤرخين، ويتحول “القانون” نفسه من قاعدة عامة مجردة إلى نص مطاط وغامض يُفسر في الغرف الأمنية المغلقة، يصبح المجتمع بلا ذاكرة وبلا قدرة على التوقع. هذا التيه المتعمد هو المحرك الفعلي لما أسميناه سابقاً “اقتصاد الخوف“؛ فالخوف في جوهره هو “ابن المجهول“، وحين يجهل المواطن حدود المخاطرة الحقيقية، ويغيب عنه اليقين بشأن ما هو مباح وما هو محظور، فإنه يميل لا إرادياً إلى اختيار الانسحاب التام والصمت المطلق، بوصفهما استراتيجية النجاة الوحيدة المتبقية في غابة من الأسلاك الشائكة غير المرئية.
إن البحث عن مخرج حقيقي يبدأ بالضرورة من تحويل المعرفة من مجرد “رصد سلبي للمظالم” أو استعراض لآثار القمع، إلى “أداة لامتلاك الواقع“. المعرفة المقاوِمة هي تلك التي ترفض الاكتفاء بدور الضحية التي تصرخ لتعلن عن ألمها، لتلعب دور الفاعل الذي يشرح المنظومة، ويفهم تروسها، ويتنبأ بمساراتها. التوثيق في هذا السياق ليس مجرد تسجيل تاريخي بارد لما حدث، بل هو بناء صلب لـ “سردية بديلة” تشتبك مباشرة وبشراسة مع زيف الأحكام القضائية والحقائق المصنوعة بعناية في محاضر التحريات والبيانات الرسمية. عندما ننجح في توثيق نمط معين في إدارة الشأن العام، أو نكشف آليات هندسة القوانين الاستثنائية التي تُفصّل لخدمة لحظة بعينها، أو نرصد الثغرات الإجرائية التي تتسلل منها السلطة لتقنين اللاعدالة، فنحن لا نجمع أوراقاً فحسب، بل نحن ننتزع من السلطة أهم أسلحتها على الإطلاق: احتكارها لتعريف “الحقيقة” وفرضها لمنطق “الواقع البديل“. فالمعرفة هنا هي التي تمنع السلطة من إعادة كتابة التاريخ بينما هو لا يزال يحدث أمام أعيننا.
إن أزمة الفعل الجماعي التي تضرب مجتمعنا مرتبطة بنيوياً بتفتت المعرفة وتجزئتها المتعمدة. نحن نعيش في مجتمع يمتلك آلاف الحكايات الفردية الصادقة والمؤلمة عن الظلم والانتهاك، لكنه يفتقر إلى “المعرفة التشابكية” التي تربط هذه الخيوط ببعضها لتكشف البنية الكلية للسلطة ووظائفها. التنظيم الذي نسعى لاستعادته يحتاج إلى هذه المعرفة كحاجة الجسد إلى البصر؛ يحتاجها ليعرف أين يضع قدمه في حقل الألغام القانوني والسياسي، ومتى يكون التقدم ممكناً، وكيف يحمي أفراده من السقوط في أفخاخ التخبط أو الاندفاع غير المحسوب. المعرفة هي التي تحول “الخطر الداهم” المجهول والساحق إلى “مخاطرة محسوبة” يمكن التعامل معها بالصبر والمناورة، وهي التي تمنح الأفراد شعوراً بأنهم لا يتحركون في عتمة مطلقة، بل يستندون إلى أرض صلبة من الحقائق والبيانات التي بُذل جهد مضنٍ لانتزاعها من بين مخالب الصمت والسرية. ومن دون هذه المعرفة، يتحول التنظيم إلى مجرد انتحار جماعي أو حلقة مفرغة من ردود الأفعال العاطفية التي تنتهي دائماً بالإحباط.
علاوة على ذلك، تلعب المعرفة دوراً حاسماً في “ترميم الرابط الاجتماعي” الذي مزقته سياسات صناعة الأعداء والفرز الطائفي والسياسي. السلطة تنجح في تحويل المواطنين إلى أطراف متناحرة ومذعورة من بعضها البعض لأنها تزرع الجهل بالآخر، وتجعل من كل “مختلف” تهديداً مجهولاً للهوية أو الاستقرار المزعوم. استعادة المعلومات وتداولها بشفافية، بعيداً عن قنوات التوجيه الرسمي التي تقتات على الكراهية، هو الكفيل الوحيد بكسر هذه العزلة القاتلة. عندما يدرك الناس، عبر المعرفة الموثقة والبيان الحقيقي، حجم اشتراكهم في المعاناة من ذات السياسات الاقتصادية الفاشلة أو ذات الانتهاكات الحقوقية الممنهجة، تبدأ ملامح “المصلحة المشتركة” في الظهور من خلف غبار الاستقطاب المصطنع. هنا تتحول المعرفة إلى “مشاع مجتمعي” يطرد الفاشية اليومية، ويحل محلها لغة العقل والمصالح والبيانات التي توحد الناس حول قضاياهم الملموسة واليومية، بدل الخوض في صراعات هوية وهمية تصنعها السلطة لتضمن ديمومة سيطرتها عبر استراتيجية “فرق تسد“.
إن المخرج المعرفي الذي نطرحه هنا لا يعني بأي حال من الأحوال انتظار صدور “قانون لتداول المعلومات” أو استجداء الشفافية من سلطة ترى في المعلومة الحقيقية تهديداً وجودياً لبقائها، بل يعني بالضرورة خلق “مسارات بديلة وموازية” لإنتاج ونشر الحقيقة. الصحافة المستقلة التي تأبى التدجين والاندماج في جوقة المطبلين، مراكز الأبحاث التي تشتبك مع الواقع الميداني وتخرج من أبراجها العاجية، المبادرات الحقوقية التي توثق الانتهاك بوصفه فعلاً سياسياً بامتياز، وحتى تداول الخبرات اليومية البسيطة والشهادات الشخصية بين الناس في الفضاءات الرقمية والواقعية، كلها روافد تصب في مجرى هذا المخرج. فالمعرفة لا تُستعاد فقط عبر المؤسسات، بل أيضًا عبر كل مساحة تُنتزع من منطق الاحتكار، سواء في كتاب متاح، أو نقاش مفتوح، أو معرفة متداولة خارج قنوات الوصاية. إنها عملية “تأميم اجتماعي للمعرفة” من جديد، وإخراج الحقيقة من الأقبية السيادية والغرف المظلمة لتصبح ملكاً مشاعاً وحقاً مكتسباً لمن يدفعون يومياً من حياتهم ومستقبلهم ثمن غيابها وتغييبها. إن المعرفة هي السلاح الوحيد الذي لا يمكن مصادرته بمجرد صدور قانون، لأنها بمجرد أن تُنتج وتُتداول، تصبح جزءاً من الوعي الجمعي الذي لا يمكن حصاره.
لكن إنتاج هذه المعرفة يواجه تحدياً آخر، وهو “تلوث الحقيقة“. فالسلطة لا تكتفي بالمنع، بل تضخ كميات هائلة من المعلومات المضللة لتغرق الحقيقة في بحر من الأكاذيب والضوضاء. هنا تصبح المعرفة كفعل تحرر هي القدرة على “الفرز” و“النقد” و“التحقق“. المخرج إذن ليس فقط في الحصول على المعلومة، بل في امتلاك المنهج الذي يسمح لنا بتمييز الخبر اليقين من الإشاعة التي تطلقها الأجهزة الأمنية لجس النبض أو لإثارة البلبلة. السياسة في جوهرها هي صراع على “المعنى“، ومن يملك القدرة على صياغة المعنى بناءً على معرفة صلبة، يملك القدرة على قيادة المجتمع نحو التغيير.
في الختام، إذا كان التنظيم هو “الجسد” الصلب الذي سيحمل مشروع البحث عن مخرج، فإن المعرفة هي “العين” البصيرة التي ترسم الطريق وتحدد الثغرات في جدار اليأس. وبدون هذا الوعي المعرفي المسلح بالبيانات والتوثيق والقدرة التحليلية، سيظل الفعل الجماعي فعلاً انفعالياً، لحظياً، وسهلاً للاحتواء أو التصفية أو التضليل. إن استعادة الحق في المعرفة، ليس فقط كمتلقين بل كمنتجين وموثقين ومحللين، هي معركة سياسية وقانونية وأخلاقية كبرى، وهي الجسر الوحيد والمؤكد الذي يمكننا من خلاله العبور من حالة “التيه في المجهول المصنوع” وصناعة الجهل، إلى حالة “الاشتباك الواعي والمنظم” مع شروط واقعنا الصعبة. ولكن، يظل السؤال الكبير قائماً في الأفق: هل تكفي المعرفة وحدها لجمع شتات مجتمع أُنهك بالانقسام العمودي ويرى في جاره وشريكه في الوطن عدواً محتماً؟ هذا ما سيحاول مقالنا القادم الاشتباك معه حين نتحدث عن ضرورة “ترميم المشترك الاجتماعي” كخطوة وجدانية وسياسية لا غنى عنها في رحلة البحث الطويلة والمضنية عن مخرج.