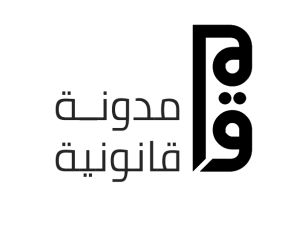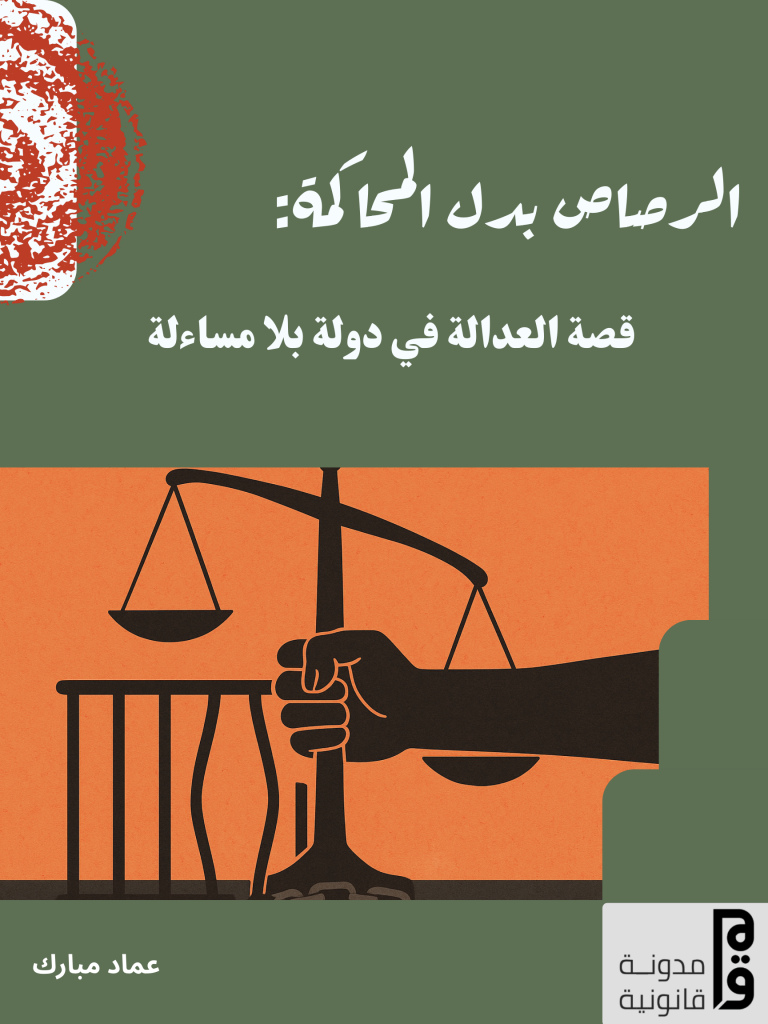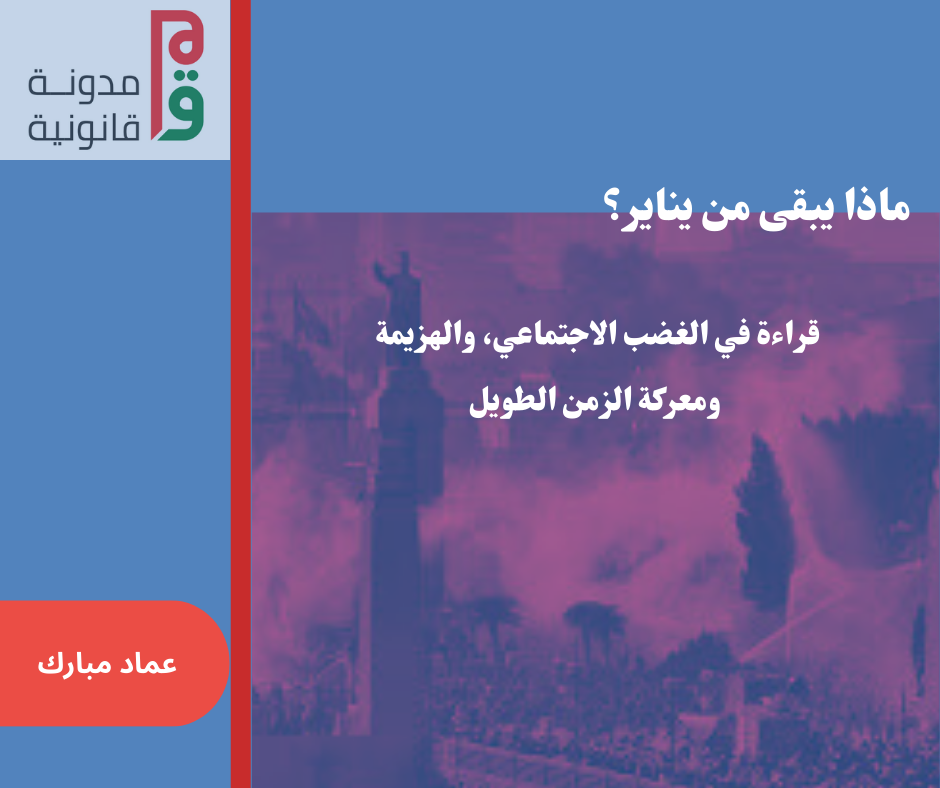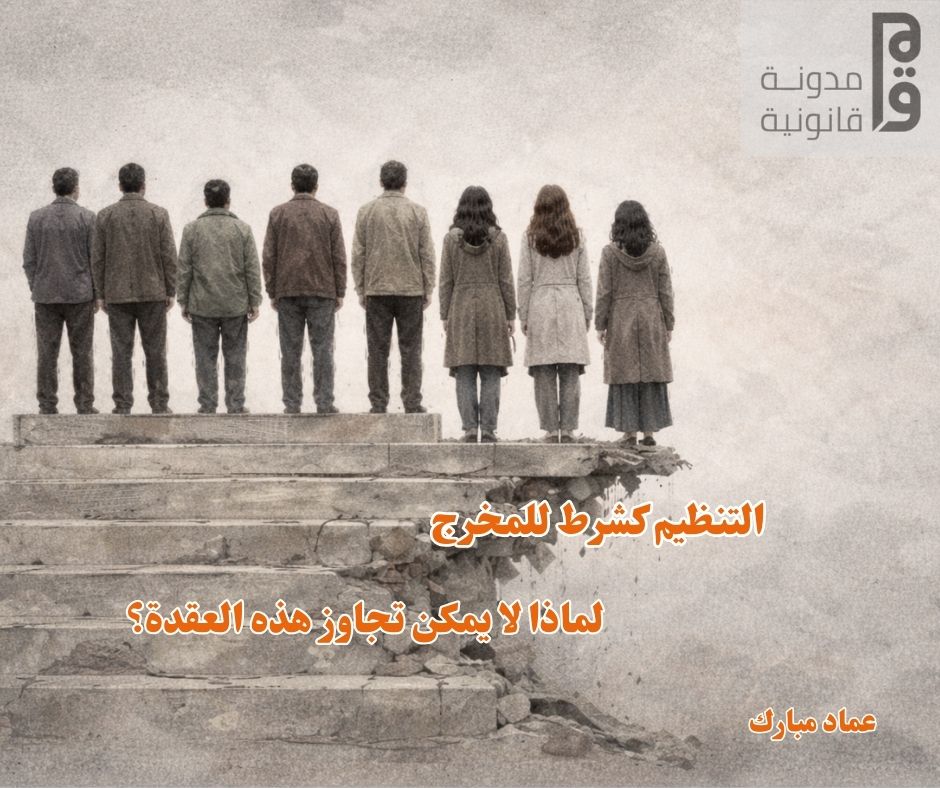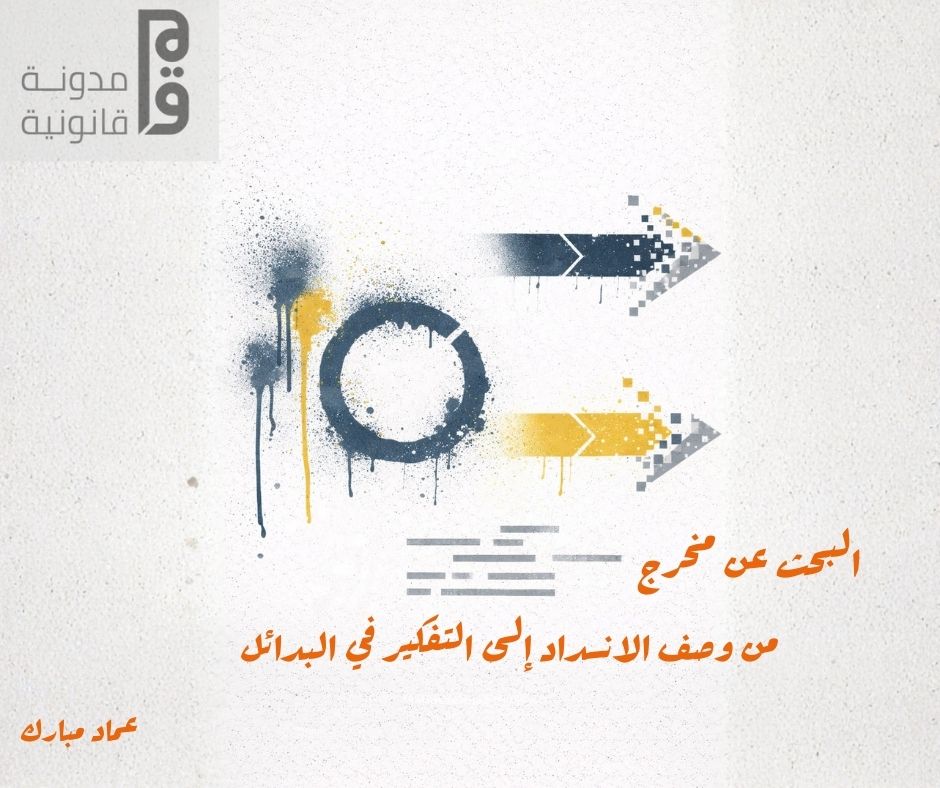لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة.
هذه ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر.
من الرصاصة إلى الصمت: حين يُعاد تعريف العدالة
خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.
لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.
في هذا السياق، لا تعود التصفية مجرد انتهاك لحق في الحياة، بل تصبح لحظة كاشفة لطبيعة العلاقة بين الدولة والرعية: علاقة لا تقوم على الاحتكام إلى قضاء مستقل، بل على تفويض مفتوح للقتل، دون تحقيق، دون محاكمة، دون أسئلة. فالتصفية لا تمثل فقط اختزالًا للعقوبة في الرصاص، بل تمثل أيضًا اختزالًا للعدالة نفسها في قرار إداري محض، خارج أي رقابة، وخارج أي مساءلة.
تتعدّد الأمثلة على هذا النمط من القتل الذي لا يمر بأي شكل من أشكال التقاضي: من تصفية خمسة أشخاص في 2016 ادعت السلطات أنهم المسؤولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر.
هكذا يُعاد تعريف “الإرهابي” لا من خلال فعل إجرامي مثبت، بل من خلال وصف تطلقه السلطة وتنفذه بنفسها، في ساحة معزولة عن القانون. وحين يُقتل المرء لأنه مشبوه، ثم يُدفن دون تحقيق، وتُغلق الصحف على بيان أمني، تكون التصفية قد نجحت في مهمتها الأعمق: إقناع المجتمع بأن القانون فائض عن الحاجة.
في هذا السياق، لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة
وحين تغيب المحاسبة، لا تعود الدولة مطالبة بالاحتكام إلى القانون، بل إلى الولاء. ويتحوّل القانون نفسه من ضابط للممارسة إلى أداة للانتقائية: يُطَبَّق على من تُريد السلطة إسكاتهم، ويُرفع عمّن تُريد حمايتهم. وهكذا، تتبدّل وظيفة العدالة من كونها أداة إنصاف إلى كونها أداة ضبط وإفلات معًا.
الإفلات كمنظومة: القضاء، النيابة، والمؤسسات المتواطئة
لم يكن من الممكن ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.
أما القضاء، الذي لطالما عُوّل عليه كضامن للحقوق، فقد شهد انزياحًا بنيويًا خطيرًا. فباسم الاستقلال، جرى تحصينه من الرقابة المجتمعية، وباسم السيادة، تم إعفاؤه من النقد، حتى بات قضاءً يعلو فوق المحاسبة بينما يتماهى مع خطاب السلطة. الأحكام التي صدرت خلال السنوات الأخيرة في قضايا سياسية وحقوقية تُظهر بوضوح أن القضاء لا يعمل فقط في ظل منطق الإفلات، بل يشارك في إنتاجه. من إصدار أحكام بالإعدام في محاكمات جماعية بلا ضمانات، إلى تجاهل شهادات التعذيب، إلى تصديق روايات الأجهزة الأمنية دون تمحيص، يبرز القضاء كفاعل رئيسي في بناء حالة اللامحاسبة، لا كحارس على القانون.
في الوقت ذاته، جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يُعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. ومن تمّت محاسبتهم داخل هذه الأجهزة لم يكونوا المسؤولين عن الانتهاك، بل من حاولوا كشفه. هذه الهندسة الدقيقة لإسكات المؤسسات من الداخل لم تتم بالقوة فقط، بل عبر إعادة تشكيل بنيتها القانونية والإدارية لتتماهى مع منطق الدولة الجديدة: دولة لا تسائل نفسها.
في هذا الوضع، لا تُصبح العدالة غائبة فحسب، بل يُعاد إنتاجها كمشهد شكلي يخفي ما هو جوهري. تصبح المحاكم إجراءات فارغة، وتتحوّل فكرة القانون إلى طقس إداري، بينما يُمارس العنف خارج النص، ويُغسَل رسميًا داخل المؤسسات.
حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.
هذا التآكل في المعنى لا يمر دون كُلفة. فالناس، وقد جرّبوا مرارًا التظلّم دون استجابة، يبدأون في الانسحاب من المجال العام، أو تبنّي أشكال فردية من النجاة لا تتضمن أي صراع من أجل العدالة. تضعف المشاركة السياسية، وتنحسر الثقة في كل ما هو مؤسسي، ويترسّخ إدراك مفاده أن “النجاة” لا تأتي من القانون، بل من العلاقات والنفوذ. بهذا الشكل، لا يُعيد الإفلات من العقاب فقط إنتاج الخوف، بل يُنتج أيضًا مجتمعًا هشًا، مفككًا، لا يرى في الدولة سوى جهة قهر، ولا يجد في القانون أي معنى للحماية أو الإنصاف.
كل ذلك لا يحدث في فراغ، بل في ظل خطاب رسمي يُشيطن الضحية، ويُقدّم السلطة باعتبارها الضامن الوحيد للنجاة. وتُصبح المطالبة بالمحاسبة، لا باعتبارها فعلًا قانونيًا، بل خطرًا على الاستقرار، يُساوي بين النقد والهدم، وبين العدالة والفوضى. وفي هذا السياق، يُعاد تعريف المواطن لا باعتباره فاعلًا سياسيًا له حقوق، بل باعتباره تابعًا يُكافَأ بالصمت، ويُعاقَب إذا تجرّأ على السؤال.
لكن تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.
هذا الصمت لا يُفهم إلا ضمن نظام دولي يُنتج العدالة بانتقائية. فمنظومة الأمم المتحدة، رغم ما تحمله من نصوص صريحة بشأن الحق في المحاسبة والإنصاف، تفتقر إلى الآليات الملزمة، وتخضع في قراراتها لموازين القوة لا لميزان الحق. وما لم تتعارض الجريمة مع مصالح الدول الكبرى، فإنها تمر بلا مساءلة. هذه الازدواجية لا تُبرّئ الداخل، لكنها تفضح كيف أن الإفلات من العقاب لم يعُد أزمة محلية فحسب، بل أصبح جزءًا من منطق سياسي عالمي، لا يرى في العدالة قيمة أخلاقية، بل ورقة ضغط تُستخدم أو تُهمل بحسب المصلحة.
في هذا السياق، لا يعود السؤال مقتصرًا على من يُعذّب أو يقتل أو ينهب، بل على من سمح له أن يفعل ذلك لسنوات دون حساب. الإفلات من العقاب ليس فشلًا في تطبيق القانون، بل نتيجة لتوازن معقّد من الصمت الداخلي والرضا الخارجي. ومواجهته لا تبدأ فقط بمراجعة مؤسسات العدالة، بل أيضًا بكسر هذا التواطؤ المزدوج: أن نقول للأجهزة التي تُفلت من المحاسبة إنها ليست فوق القانون، وأن نقول لحلفائها الدوليين إن الشراكة مع المنتهكين لا تُصنع باسم الاستقرار، بل على حسابه.