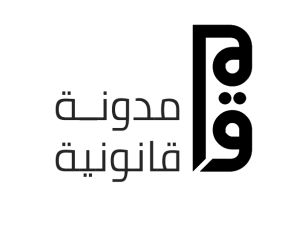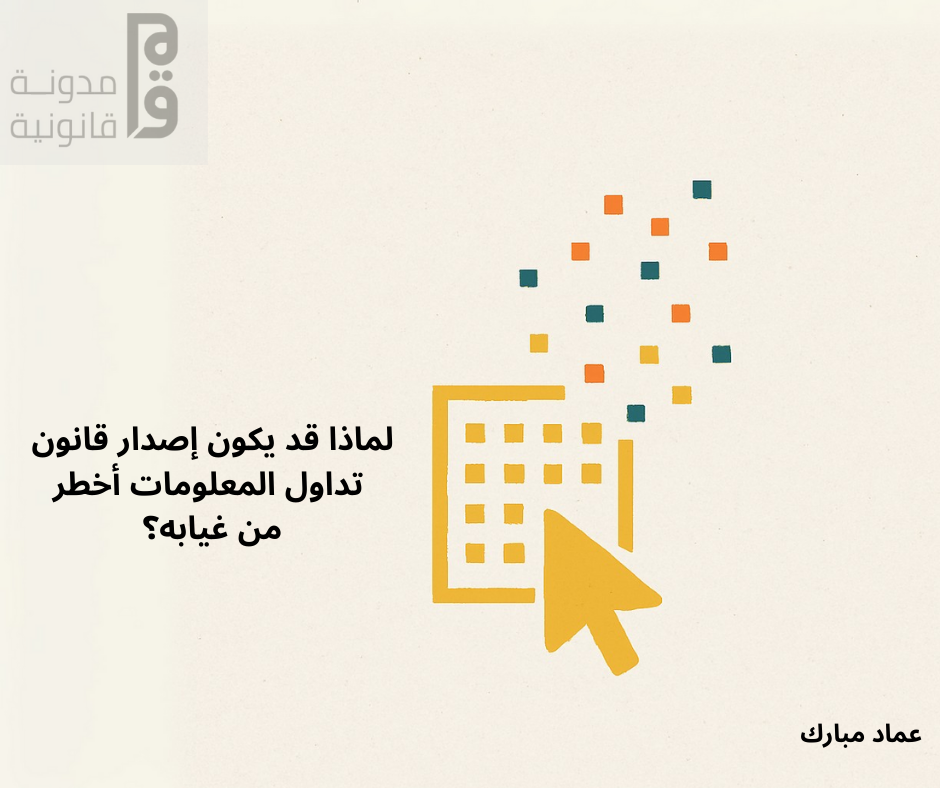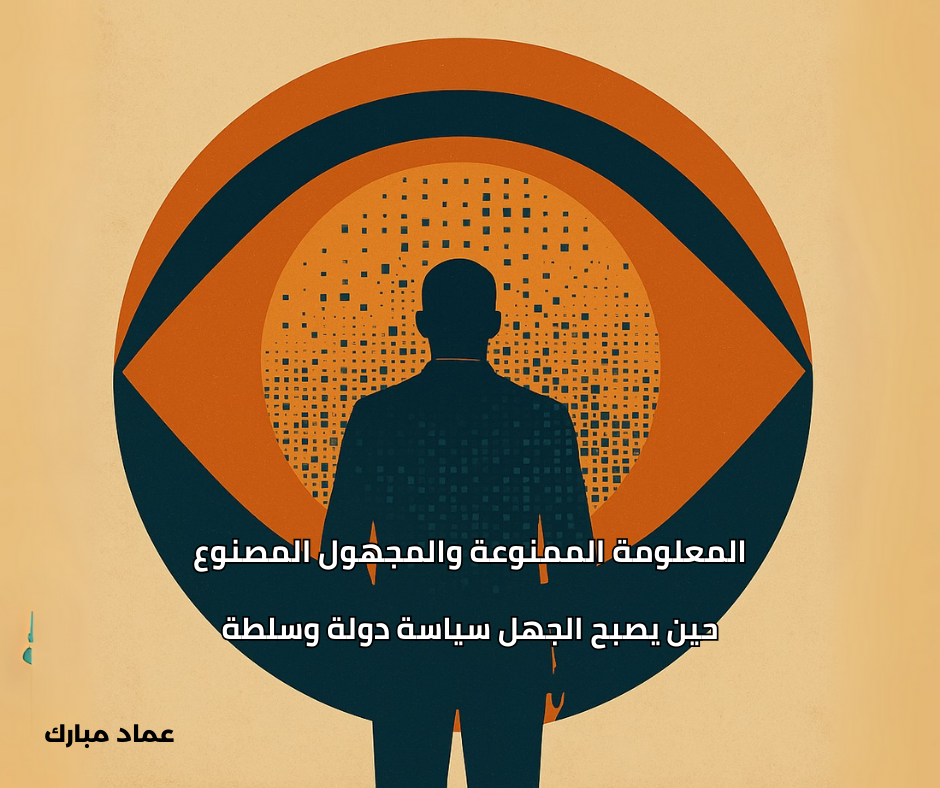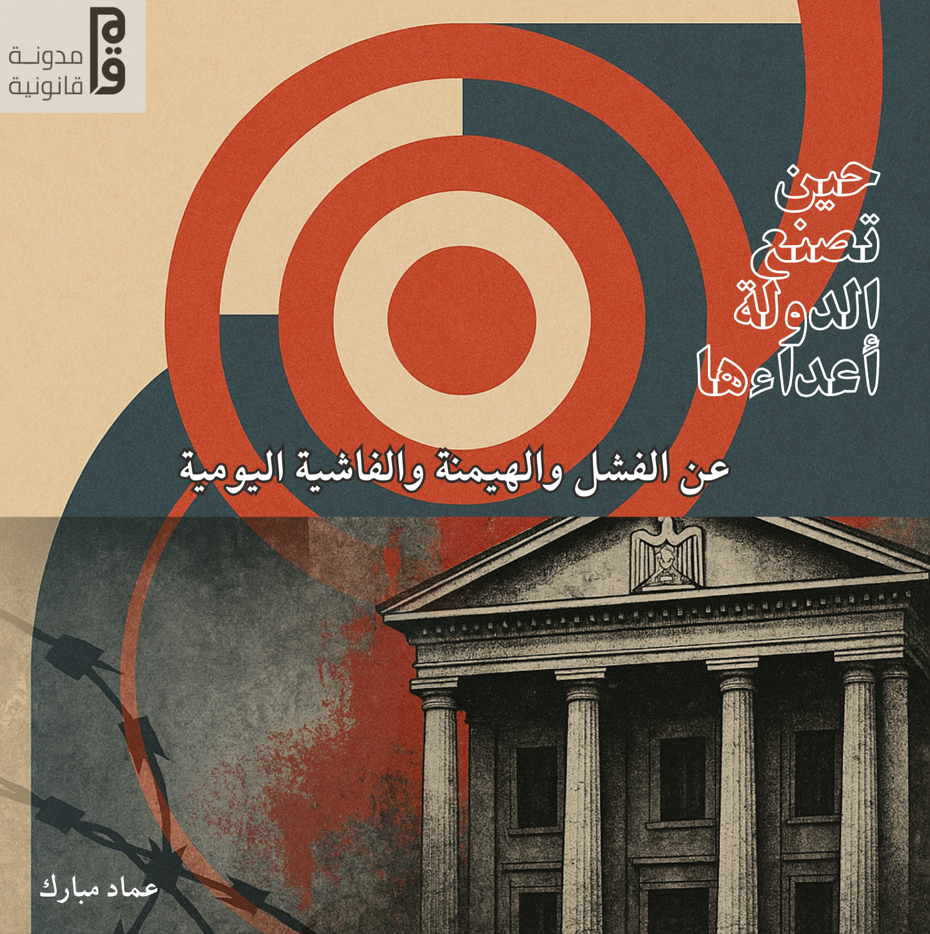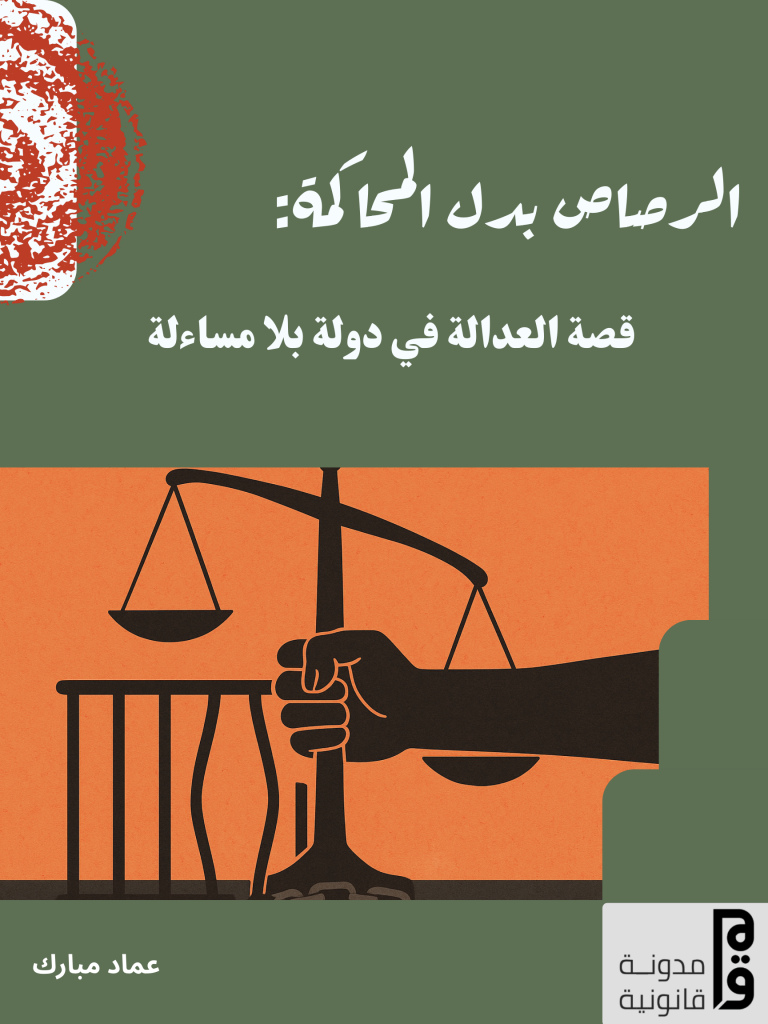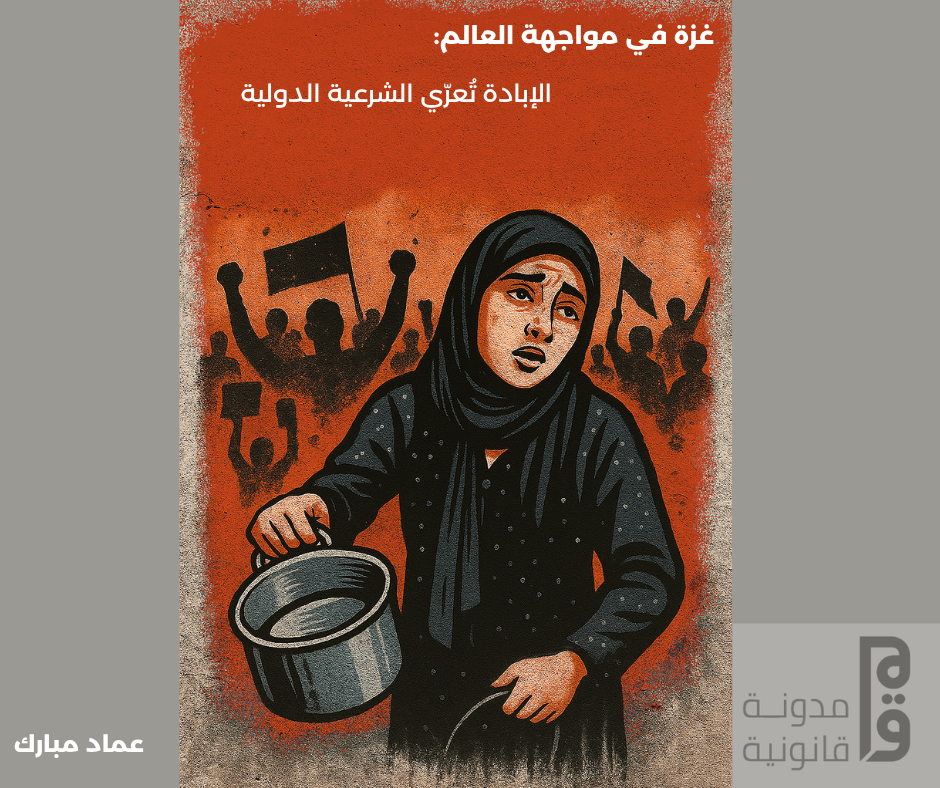هل يُنقذ القانون الحقّ حين يولد في بيئة مغلقة؟ السؤال يبدو بسيطًا، لكن الإجابة عليه تحدّد مصير حرية تداول المعلومات لسنوات قادمة. موقفي الرافض لإصدار قانون لتداول المعلومات الآن لا يعني التنازل عن الحق ولا الانسحاب من الدفاع عنه. العكس تمامًا: هو محاولة لحماية الحق من أن يُفرَّغ من مضمونه تحت رعاية نصّ جديد. الخطر ليس في غياب القانون، بل في حضوره على النحو الذي يجعله واجهة أنيقة لتقنين المنع.
المعلومة ليست بندًا إداريًا ولا تفصيلة تقنية. المعلومة علاقة سلطة: من يمتلكها، من يوزّعها، ومن يقرّر الحجب والإفصاح. وحين تُصاغ القواعد داخل سياق تشريعي مُحكَم تُحتكر فيه القرارات التنفيذية وتغيب أدوات الرقابة الفعلية، لا يعود القانون أداة تمكين، بل يصبح جزءًا من هندسة السيطرة. عندها تتحوّل “التنظيمات” إلى قيود، ويغدو الحق اسمًا مُعلّقًا على واجهة لا تُفتح.
لا أكتب هذا من موقع المراقِب، بل من تجربة مباشرة ممتدة منذ 2011. بدأت من صياغة أول مسودة حقوقية مستقلة، مرورًا بجلسات التفاوض مع مركز دعم واتخاذ القرار، ثم لاحقًا مع وزارة العدل حين طُلِبَت مساهمات المجتمع المدني. وفي كل محطة تكرّر النمط نفسه: حوار شكلي يترك الجوهر على حاله؛ توسّع في الاستثناءات، وتعميم لمفاهيم فضفاضة مثل “الأمن القومي“، وغياب إرادة لإنشاء جهة رقابية مستقلة قادرة على الإلزام. والنتيجة واحدة: نص يُقال إنه “ينظّم الحق“، بينما يعيد إنتاج المنع بلغة قانونية أكثر نعومة.
لهذا أرى أن المطالبة بالتأجيل ليست تعطيلًا للإصلاح، بل شرطًا له. الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من عناوين القوانين، بل من بيئة سياسية وقضائية وإعلامية تضمن أن يعمل النص كأداة شفافية ومسائلة، لا كغطاء جديد للحجب. أي قانون يولد تحت سقف أحادي سيكرّس المشكلة بدل أن يحلّها. ومن ثم، فإن الدفاع عن الحق اليوم يعني مقاومة صدور قانون يُعيد تعريف الحق على مقاس السلطة، ويحوّل المواطن من شريك في المعرفة إلى متلقٍ مُراقَب لما تسمح به الجهة الحاكمة.
من خبرة الصياغة إلى تجربة التفاوض: دروس من الماضي
حين انفتحت أبواب السياسة بعد ثورة يناير، بدا الحق في الوصول إلى المعلومات كأنه واحد من المطالب الطبيعية لمرحلة انتقالية تتطلّع إلى الشفافية. عقود طويلة من السرية والحجب صنعت جدارًا كثيفًا بين المجتمع والقرار العام، وكان من البديهي أن يُطرح هذا الحق بوصفه مدخلًا لإعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطن. لكن منذ اللحظة الأولى، اتضح أن الطريق إلى القانون لن يكون امتدادًا بديهيًا لذلك الزخم، بل ساحة صراع جديدة حول تعريف الحق وحدوده.
في عام 2011 شاركتُ مع مجموعة من المنظمات الحقوقية والخبراء القانونيين في إعداد أول مسودة مستقلة لقانون تداول المعلومات. لم يكن الهدف إعادة إنتاج نصوص أجنبية، بل صياغة نموذج مصري يستفيد من التجارب المقارنة في تونس وجنوب أفريقيا والمكسيك، لكنه يستجيب لخصوصية المرحلة الانتقالية. جوهر الفكرة كان بسيطًا لكنه راديكالي: المعلومة مورد عام، والحق في الحصول عليها لا يُنظَّم إلا بقدر ما يضمن اتساعه، لا تضييقه. لذلك تضمنت المسودة آليات نشر استباقي، وحدودًا واضحة للاستثناءات، وتعريفات دقيقة لمفاهيم مثل “الأمن القومي”، مع نصوص تضمن حماية المبلّغين وتتيح الطعن القضائي السريع على قرارات الحجب.
لكن هذا المشروع، بكل ما حمله من جهد جماعي، ظلّ حبيس المجتمع المدني. لم يُدرج كمرجع في أي مسار رسمي، وحتى حين طُرحت مشاريع قوانين لاحقة على البرلمان، ومنها جلسات استماع حضرتُ بعضها بنفسي، كان واضحًا أن المسودات الحقوقية المستقلة غائبة تمامًا عن النقاش، وأن الهدف لم يكن تمكين الحق بل احتواؤه.
المرحلة التالية جاءت حين أطلقت وزارة العدل مشروعها الخاص. تلقّيت دعوة رسمية للمشاركة في مراجعته، فنسّقت لقاءات بين ممثلين عن الوزارة وعدد من المنظمات الحقوقية. في البداية، بدا وكأن هناك نافذة للحوار، لكن سرعان ما تبيّن أن ما يُعرض علينا ليس مشروعًا مفتوحًا للتعديل، بل نصًّا مُحكمًا صيغت روحه مسبقًا. الاستثناءات الواسعة ظلت كما هي، مصطلح “الأمن القومي” ظل بلا تعريف، بعض المؤسسات أُعفيت من الخضوع للقانون بالكامل، والجهة المفترض أن تراقب التنفيذ ظلت خاضعة للسلطة التنفيذية نفسها.
كانت التجربة كاشفة: السلطة لم ترد قانونًا يفتح باب الشفافية، بل نصًا يضبط المجال باسم “التنظيم”. الاستماع إلى ملاحظاتنا كان يقتصر على تفاصيل شكلية، بينما الجوهر بقي كما هو: تكريس السرية بوسائل قانونية. وكلما غُيّر المسؤول الحكومي المكلّف بالملف، كان علينا أن نعيد النقاش من البداية، وكأن الغرض من الحوار هو استنزاف الوقت وإضفاء شرعية شكلية على مسار تقرّره السلطة وحدها.
من هنا تشكّلت القناعة التي ما زالت ترافقني: أن المشكلة ليست في “نص قانون” غائب، بل في منطق إنتاجه والبيئة التي يولد فيها. ما لم تتغير هذه البيئة، فإن أي مشروع سيظل محكومًا بالمنطق ذاته: التنظيم كغطاء للحجب، والمشاركة كديكور للتسويق الخارجي، بينما يظل الحق بعيدًا عن متناول الناس.
أين يكمُن الخطر الآن؟
الخطاب السائد اليوم يُقدَّم وكأن إصدار قانون لتداول المعلومات خطوة إصلاحية لا تحتمل التأجيل. لكن السؤال الحقيقي هو: أي إصلاح يتحقق إذا صدر النص في مناخ سياسي مغلق؟ التجارب السابقة تكفي لتوضيح أن القانون في مثل هذه الظروف لا يوسّع الحق بل يضيّقه، ولا يفتح الشفافية بل يكرّس السرية في صورة جديدة.
قد يجادل البعض بأن هذه المطالبة بالتأجيل هي في حد ذاتها تعطيل لإصلاح طال انتظاره، وأن وجود القانون، حتى لو كان قاصراً، أفضل من غيابه. يرى هذا المنطق أن أي نص قانوني هو خطوة أولى، يمكن البناء عليها وتطويرها في المستقبل، وأنه يرسخ المبدأ وإن لم يرسخ الممارسة الكاملة. لكن هذه الحجة تتجاهل التجربة الواقعية، فما يُقدَّم بوصفه خطوة أولى قد يتحول إلى خط النهاية، وما يُسَوَّق كقانون يمكن تطويره يصبح في الحقيقة أداة لتحصين الوضع القائم. إن الخطر ليس في الفراغ القانوني، بل في أن يُملأ هذا الفراغ بنص يُجمل المنع ويُشرعنه بدلاً من أن يفتح الباب للشفافية.
الخطر هنا ليس في الورق، بل في الفلسفة التي تُنتج الورق. حين تُصاغ التشريعات تحت سقف أمني، تصبح وظيفتها الأساسية هي تنظيم الحجب لا تنظيم الإتاحة. تُترك المفاهيم الجوهرية بلا تعريف، مثل “الأمن القومي” أو “المصلحة العليا”، فيتحول الغموض إلى أداة جاهزة لتقييد أي معلومة. تُفرض استثناءات مؤسسية تعفي جهات كاملة من الخضوع للقانون، وكأن هناك مناطق محصّنة ضد الشفافية. تُبقي السلطة التنفيذية يدها على آليات الرقابة، فتتحول الجهة الرقابية إلى تابع لا إلى ضامن. وفي النهاية، يُصبح النص نفسه تجسيدًا لفكرة أن المواطن لا يستحق المعرفة، بل يُمنح منها ما تسمح به الأجهزة.
هذه ليست فرضيات، بل منطق متكرر. فقد رأينا كيف استُخدمت نصوص قائمة لتجريم الصحافة، أو ملاحقة باحثين ونقابيين كشفوا وقائع فساد داخل مؤسساتهم. في كل مرة، تُستدعى تهم تتعلق بالأمن القومي أو إفشاء أسرار الدولة، حتى لو كان ما جرى نشره لا يتجاوز بيانات إدارية أو مالية. الرسالة ثابتة: المعلومة في ذاتها خطر، والإفصاح عنها تهديد، والشفافية علامة ضعف.
النتيجة أن الدعوة إلى “تنظيم الحق” تصبح خديعة لغوية. فالتنظيم، في غياب ضمانات مؤسسية وقضائية وإعلامية، ليس سوى تعبير آخر عن المنع. وما يُقدَّم بوصفه تقدّمًا تشريعيًا قد يكون في حقيقته تراجعًا مقنّعًا، يربط الحق بقيود جديدة ويحوّله إلى استثناء يُنتزع لا قاعدة تُمارَس.
من هنا يصبح التأجيل موقفًا عقلانيًا، لا مجرّد تحفظ. لأن إصدار القانون الآن يعني تثبيت منطق الحجب في نص حديث، يُسوّق كإنجاز، بينما هو في جوهره إعادة إنتاج للهيمنة بلغة أكثر نعومة. الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من إعلان قانوني، بل من تغيير البنية التي ترى في المعرفة تهديدًا وتحوّلها إلى مورد مُتاح، يخضع للمساءلة والرقابة المجتمعية.
المنطق الأمني مقابل منطق الحق
كل ما سبق يكشف عن صدام جوهري بين منطقين لا يلتقيان. الأول هو منطق السلطة الذي يتعامل مع المعلومة كملكية سرية، لا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود التي تضمن استمرار السيطرة. في هذا التصور، السرية هي القاعدة، والشفافية استثناء يحتاج إلى مبرر. المواطن ليس شريكًا في إدارة الشأن العام، بل مخاطَر محتمل يجب مراقبته وتقييد وصوله إلى المعرفة.
في المقابل، هناك منطق الحق: المعلومة مورد عام، والإفصاح عنها هو الأصل، والحجب لا يكون إلا في أضيق الحدود ووفق شروط دقيقة تخضع للرقابة المستقلة. هذا المنطق لا يحمي فقط حرية التعبير والشفافية، بل يرسخ كفاءة مؤسسات الدولة نفسها، لأن الدولة التي تُخفي بياناتها تضعف قدرتها على التخطيط وعلى كسب ثقة مواطنيها.
المفارقة أن السلطة تبرر السرية باسم الحماية. لكنها في الواقع تُحوِّل الحجب إلى سلاح يوجَّه ضد المجتمع نفسه. فكلما اتسعت دوائر الاستثناءات، تقلّصت إمكانات المساءلة، وتحوّل القانون إلى واجهة قانونية لإدامة منطق الأمننة. حينها يصبح القانون أداة لإعادة إنتاج الصمت: نص يُكتب باسم الإصلاح لكنه يشتغل كآلية ضبط.
هذه المفارقة لم تكن نظرية. فقد كشف مقال خالد فهمي «لأمن القومي وعلب السردين» [مرجع] ببلاغة كيف يعمل هذا المنطق: أي معلومة، مهما كانت بسيطة أو هامشية، يمكن أن تُصنّف تهديدًا إذا نظرت إليها الأجهزة بعقلية الاستخبارات. والمثال الساخر عن علب السردين لم يكن مجرد حكاية طريفة من الستينيات، بل استعارة مكثفة عن عقلية ما زالت قائمة: عقلية تعتبر أن الإفصاح ضعف، وأن الجهل حماية.
بين المنطقين تتحدد ملامح المستقبل. فإذا ساد منطق الأمن، صار القانون الجديد غطاءً لإعادة إنتاج السرية. أما إذا أُرسيت قواعد منطق الحق، فالقانون يصبح أداة شفافية ومساءلة. السؤال إذن ليس: هل نصدر قانونًا؟ بل: أي منطق سيحكم هذا القانون؟ وأي بيئة سياسية ستضمن تطبيقه؟
الحد الأدنى قبل أي قانون
إذا كان النقاش حول قانون تداول المعلومات جادًا، فهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. لا معنى لقانون يرفع شعار الحق بينما يفرغه من مضمونه. ولهذا يصبح الحديث عن “الحد الأدنى” ليس ترفًا تشريعيًا، بل شرطًا لبقاء النص في دائرة الحماية لا في دائرة الحجب.
أول هذه الشروط أن تُعرَّف المفاهيم المركزية بدقة. الأمن القومي، العلاقات الخارجية، المصالح العليا، كلها كلمات تصلح لتبرير أي شيء إذا تُركت بلا تحديد. التعريف ليس مسألة لغوية، بل ضمانة عملية: هو الذي يحدد متى يُقبل الحجب ومتى يتحول إلى اعتداء على الحق. ومن دون هذا التعريف، سيظل الباب مفتوحًا أمام استخدام الغموض كسلاح ضد الشفافية.
الشرط الثاني هو استقلال الجهة الرقابية. لا معنى لمفوَّض معلومات يتبع السلطة التنفيذية التي تُمسك بالمعلومة أصلًا. الجهة المستقلة ليست تفصيلة إدارية، بل عمود ارتكاز لأي قانون يطمح إلى الفعالية. غيابها يعني ببساطة أن الخصم هو الحكم، وأن الرقابة شكلية.
ثالثًا: النشر الاستباقي. الحق لا يكتمل بالانتظار السلبي لمَن يطلب المعلومة، بل بالالتزام الإيجابي من الجهات الرسمية بإتاحتها دوريًا وفق جداول زمنية واضحة، وبصيغ مفتوحة تسمح باستخدامها. أي نص يتجاهل هذا البُعد يتحول إلى قانون للأرشفة، لا للشفافية.
ثم تأتي حماية المبلّغين. من يكشف الفساد أو يفضح الانتهاك يجب أن يلقى الحماية، لا أن يُحوَّل إلى متهم. هذه ليست مسألة أخلاقية فقط، بل شرط عملي لتشغيل أي منظومة معرفة. فبدون حماية، لن يجرؤ أحد على الإفصاح، وسيظل الحق معلقًا على ورق بلا حامٍ.
أخيرًا، لا يمكن فصل القانون عن باقي المنظومة التشريعية. النص الجديد سيفقد معناه إذا استمرت القوانين الأخرى في تجريم النشر أو ملاحقة الصحفيين والباحثين. المواءمة هنا ليست تكميلية، بل ضرورية: فلا معنى لحق يضمنه نص ويصادره آخر.
هذه الخطوط ليست برنامجًا مثاليًا، بل الحد الأدنى. وما لم تُدرج في أي مشروع جدي، فإن ما يُطرح تحت اسم “قانون لتداول المعلومات” لن يكون إلا إعادة إنتاج لأدوات الحجب، بل وتحصينها بشرعية جديدة.
أخيرًا
الدفاع عن الحق في المعرفة لا يعني استعجال قانون يولد في بيئة خانقة، بل أحيانًا يعني الوقوف ضد صدوره حتى لا يتحول إلى أداة لشرعنَة الحجب. الإصلاح لا يبدأ من نص يُكتب في قاعات مغلقة، بل من إرادة سياسية تفتح المجال للرقابة والمساءلة وتعتبر المعلومة ملكية عامة وليست امتيازًا سياديًا.
ما يُطرح اليوم ليس مجرد مشروع قانون، بل محاولة لإعادة تعريف الحق على مقاس السلطة. فإذا صدر في صورته المتوقعة، سيُستخدم كسلاح ناعم ضد الصحافة والباحثين والمجتمع المدني، لا كآلية لتمكينهم. هنا يصبح التأجيل موقفًا مسؤولًا، لا عرقلة. لأن القانون الذي يولد بلا ضمانات، وبلا بيئة ديمقراطية حاضنة، لا يضيف إلى رصيد الحقوق، بل يخصم منه.
لذلك أرفض أن يُختزل الحق في المعرفة إلى لافتة قانونية تُرفع في مؤتمر صحفي. ما نحتاجه ليس نصًا للتباهي الخارجي، بل إطارًا حقيقيًا يُكتب في ظل انفتاح سياسي ويخضع لرقابة مؤسسية مستقلة ويشارك فيه المجتمع المدني مشاركة فعلية. من دون ذلك، ستظل كل دعوة إلى تشريع القانون الآن محاولة لتجميل الهيمنة، لا لتقويضها.
إن حماية الحق في هذه اللحظة لا تكمن في إصداره، بل في منع تشويهه. وهذا هو جوهر الموقف: أن نؤجل اليوم كي لا نُقبر الحق غدًا.