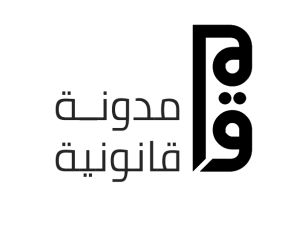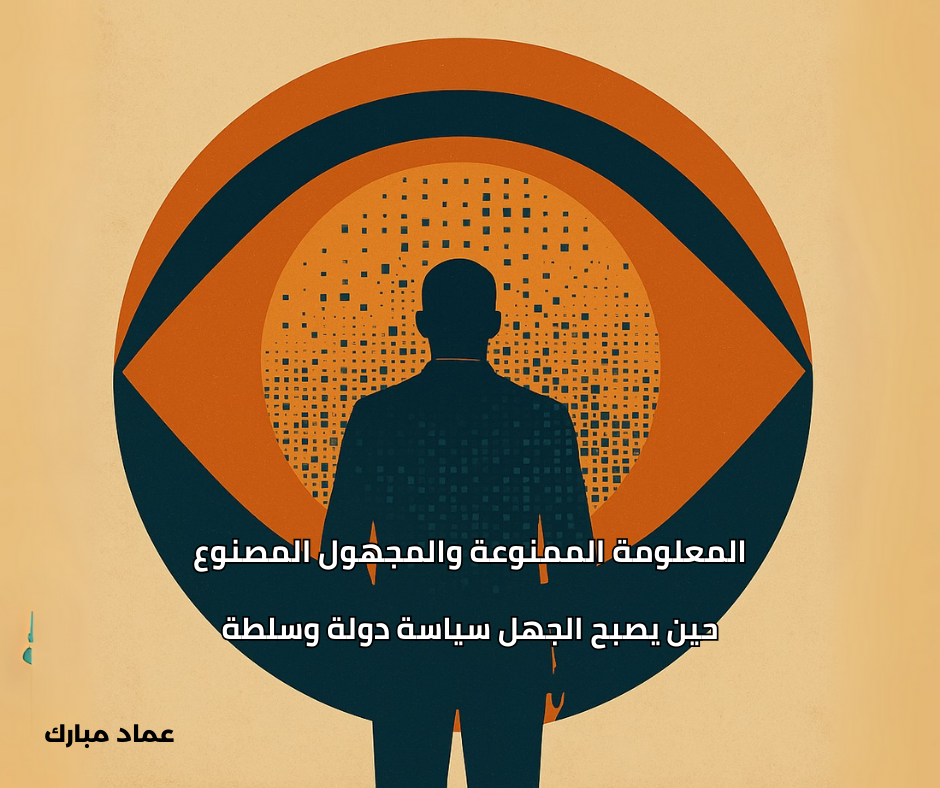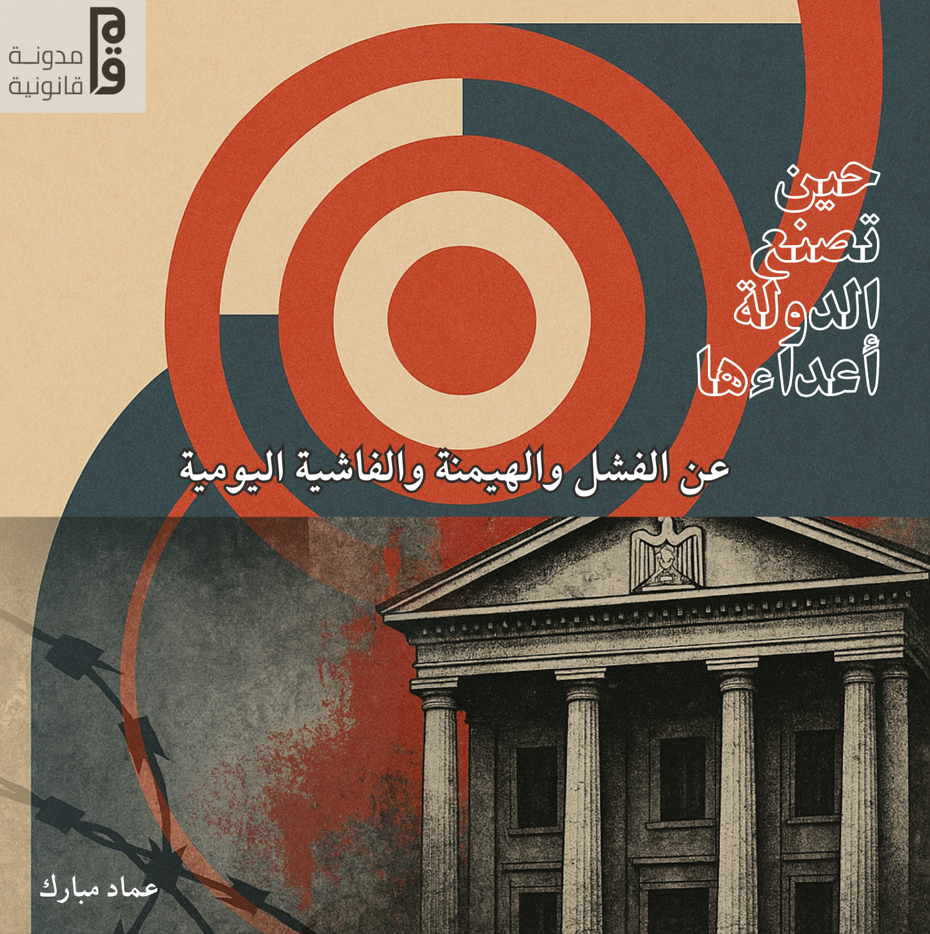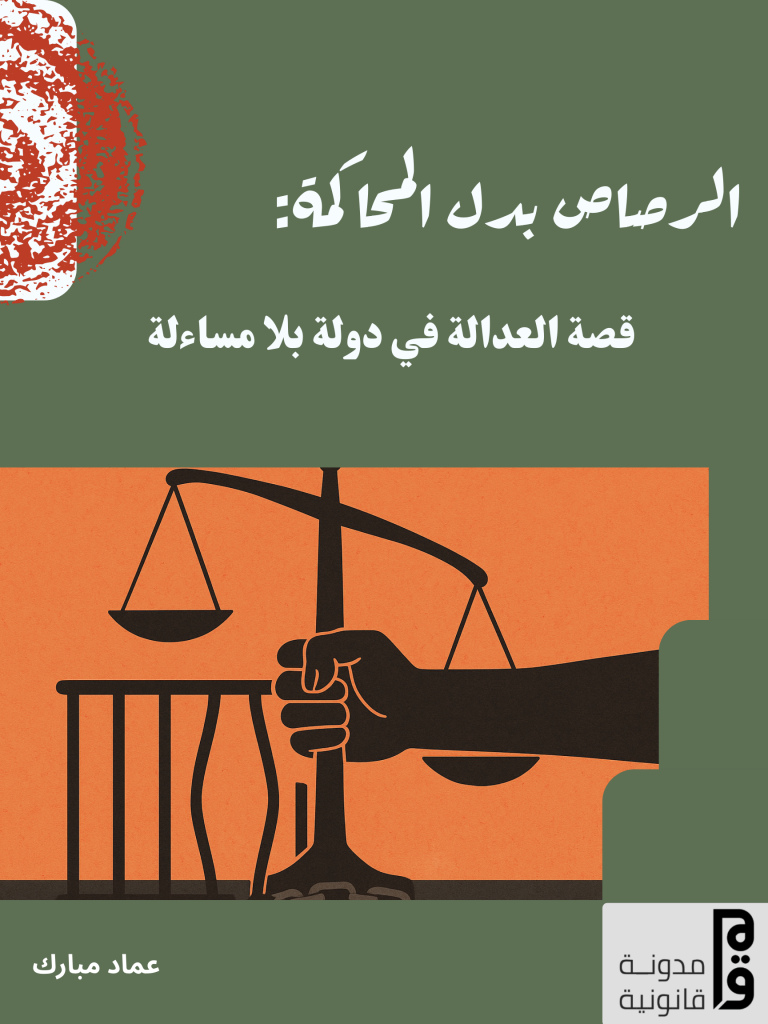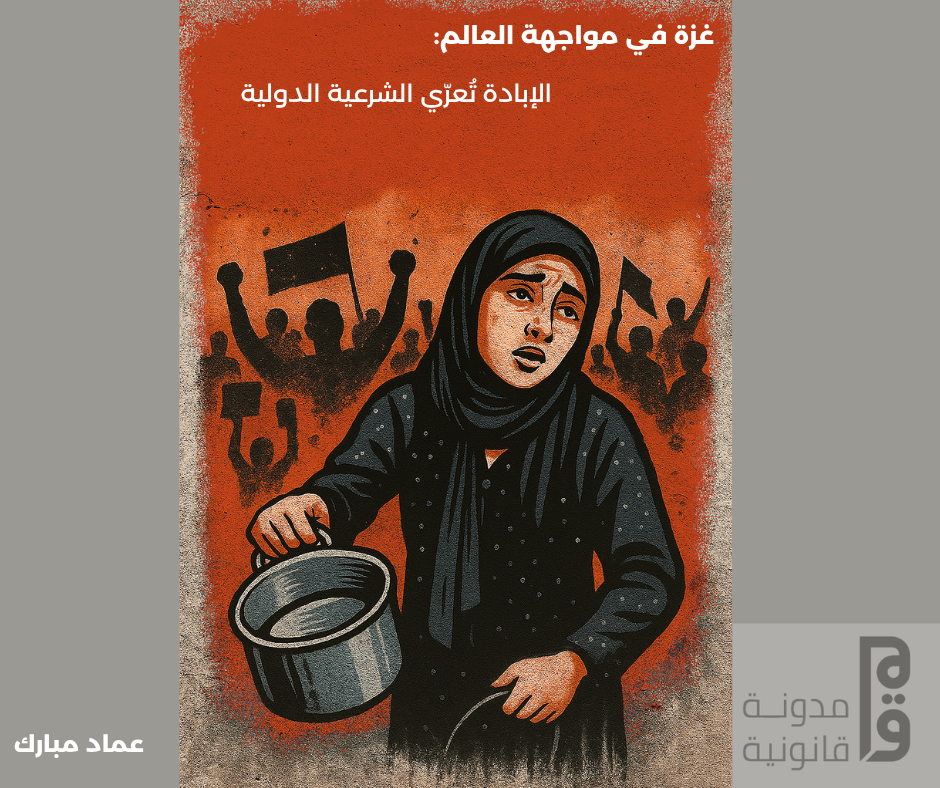هل الحكم عنوان الحقيقة؟
تفكيك الشعارات المقدسة حول القضاء
في خطاب الدولة، وفي صفحات الصحف الرسمية، وفي قاعات المحاكم أحيانًا، تتردّد عبارة “الحكم عنوان الحقيقة” كأنها مسلّمة لا تقبل النقاش. تُستخدم هذه الجملة، كثيرًا، لإغلاق النقاش العام حول قضية مثيرة للجدل، أو لحسم الجدل بشأن وقائع ما زالت ملتبسة، أو حتى لنزع الشرعية عن أي اعتراض يُبدي شكوكًا في عدالة الإجراءات أو نزاهة التحقيق. لكن، ما الذي تعنيه هذه العبارة حقًا؟ وهل يجوز التعامل معها بوصفها مبدأً أخلاقيًا أو قانونيًا فوق النقد؟
في أصلها، العبارة تعود إلى مفاهيم إجرائية داخل المنظومة القانونية: فالحكم النهائي الصادر من محكمة مختصة يتمتع بحجية قانونية تلزِم الجميع، بما فيهم الدولة نفسها، باحترامه وتنفيذه. هذا لا يعني أن الحكم يُعبّر بالضرورة عن الحقيقة الموضوعية أو العدالة المجردة، بل فقط أنه يمثّل الحقيقة القانونية، أي ما توصّل إليه النظام القضائي ضمن أدواته ووسائله.
لكن الخلط بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية هو المدخل الأول لتقديس الحكم القضائي وتحويله إلى “نهاية مطلقة” لا يجوز مراجعتها. فالتاريخ القانوني، محليًا وعالميًا، مليء بالأحكام التي ثبت لاحقًا أنها كانت خاطئة أو جائرة أو قائمة على اعترافات مُنتزعة بالإكراه أو تحقيقات مشوّهة أو دفاع غائب. بعض هذه الأحكام تمّ تصحيحه بعد سنوات، وبعضها ظلّ قائمًا رغم الأدلة اللاحقة.
في السياق المصري، ما أكثر القضايا التي أُغلقت قضائيًا، بينما ظلّت أسئلتها مفتوحة في وجدان الناس: من قضايا تعذيب لم تصل أبدًا إلى قاعات المحاكم، إلى تبرئات مثيرة في وقائع قتل جماعي، إلى أحكام إدانة مبنية على تحريات أمنية لا تُراجع ولا تُناقش. وفي كل مرة، يُطلّ أحدهم ليُذكّرنا أن “الحكم عنوان الحقيقة“!
إن التعامل مع الحكم القضائي باعتباره تجسيدًا للحقيقة المطلقة، لا يختلف كثيرًا عن معاملة القضاء كسلطة فوق المساءلة. فمثلما تُساءَل المؤسسات في النظم الديمقراطية، يجب أن يكون من المشروع مساءلة الأحكام القضائية – ليس بالتحريض أو العداء – بل بالتفكير والنقاش والنقد. فالعدالة، إذا كانت تستمدّ شرعيتها من ثقة الناس، فإن هذه الثقة لا تُبنى على الصمت، بل على الحق في الفحص والمراجعة.
“لا تعليق على أحكام القضاء“: حين يتحوّل الاحترام إلى صمت مفروض
إذا كانت عبارة “الحكم عنوان الحقيقة” تُستخدم لتكريس مصداقية مطلقة للحكم القضائي، فإن عبارة “لا تعليق على أحكام القضاء” تُوظَّف غالبًا كسياجٍ رمزيّ يُحيط بالسلطة القضائية، ويمنع النقاش حولها. لا أحد يُنكر ضرورة احترام القضاء، لكن السؤال الجوهري هو: ما حدود هذا الاحترام؟ ومتى يتحوّل من مبدأ دستوري إلى أداة تكميم؟
في الواقع، لا يوجد في القانون المصري – ولا في المواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة – ما يمنع نقد الأحكام أو مناقشتها علنًا، طالما لا يتضمّن ذلك تحقيرًا للمحاكم أو تحريضًا مباشرًا على القضاة أو تهديدًا لاستقلال القضاء. لكن في السياق المصري، لا يبدو أن الحديث عن ‘حرية التعبير‘ أو ‘الحق في النقاش العام‘ يمكن أن يستند فعليًا إلى حماية دستورية واقعية. فالدستور نفسه، وإن تضمّن نصوصًا تُشير إلى هذه الحقوق، إلا أن احترامه ظلّ انتقائيًا وتابعًا لموازين القوة، لا لسيادة القانون.
لكن في الممارسة، تتحوّل عبارة “لا تعليق” إلى نوع من التهديد الرمزي، حيث يُصوَّر أي نقاش قانوني أو إعلامي حول حكم ما كأنه خروج عن اللياقة، أو مساس بهيبة القضاء، أو تطاول على دولة المؤسسات. وفي قضايا كبرى مثل وقائع القتل الجماعي أو محاكمات الناشطين أو تبرئة مسؤولين أمنيين، يُستدعى هذا الشعار لإخماد أي محاولة لتحليل ما جرى، أو للتساؤل حول غياب العدالة.
الأخطر أن هذا الشعار يُستخدم أحيانًا من الإعلام أو من ممثلي الحكومة، لا للدفاع عن استقلال القضاء، بل لحماية قرارات سياسية تمّ تغليفها في عباءة قانونية. فيصبح القاضي، دون أن يدري، هو الواجهة النهائية لقرار اتُّخذ في دهاليز السياسة، ثم جرى تمريره عبر منصة المحكمة، ويُمنَع المجتمع من مساءلته لأنه “صار حكمًا قضائيًا“.
هكذا تتحوّل السلطة القضائية، في بعض السياقات، إلى سلطة محصّنة ضد النقد، لا بوصفها مستقلة، بل لأنها باتت جزءًا من معادلة السلطة نفسها. ويصبح الامتناع عن التعليق، لا تعبيرًا عن الاحترام، بل نوعًا من الصمت الإجباري، المُحمَّل بكل أشكال الخوف والرقابة الذاتية.
لكن، كيف يمكن بناء قضاء مستقل فعليًا دون نقاش مجتمعي واسع حول ما يصدر عنه؟ وكيف يمكن مساءلة منظومة العدالة إذا اعتُبر أي نقد لها جريمة أخلاقية أو خروجًا عن الإجماع الوطني؟ إن الحديث عن “دولة القانون” يقتضي بالضرورة أن يكون كلّ ما يصدر عن سلطاتها، بما في ذلك أحكامها القضائية، خاضعًا للنقاش والتقييم.
بين القانون والعدالة: لا تُقدّسوا الشكل وانسوا الجوهر
ربما يكون الخلط الأخطر في أي نقاش عام حول القضاء هو ذلك الخلط القائم – عمدًا أو جهلًا – بين الحكم القانوني والعدالة كقيمة. فالحكم هو نتيجة سلسلة من الإجراءات القانونية، قد تكون نزيهة أو معيبة، عادلة أو منحازة. أما العدالة، فهي المعيار الأخلاقي والسياسي الذي نقيس به مصداقية الحكم، ونُحدّد من خلاله ما إذا كان القانون قد خدم الغاية التي وُجد من أجلها: إنصاف الناس، لا إخضاعهم.
فقد يُصدر القاضي حكمًا مطابقًا للنص القانوني، لكنه يُكرّس الظلم لأن القانون ذاته جائر أو صُمّم للانتقام، لا لإنصاف المتهم. وقد تُجرى محاكمة بكافة الإجراءات الشكلية، لكن في ظل بيئة من الترهيب الإعلامي، وغياب المساواة في الوصول للعدالة، وانعدام الثقة العامة في نزاهة التحقيق. في هذه الحالة، حتى لو بدا الحكم “قانونيًا“، فإنه لا يُمكن وصفه بأنه “عادل“.
العدالة لا تُقاس فقط بصحة الإجراءات، بل بمضمونها. تُقاس بقدرة النظام القضائي على حماية الضعيف من تعسف السلطة، لا العكس. وتُقاس بشفافية التحقيق، بحق الدفاع، بعلنية الجلسات، باستقلال القاضي عن الضغوط، وبإمكانية الطعن والتصحيح. العدالة ليست صدىً لصوت الدولة، بل يجب أن تكون مرآة لكرامة الإنسان.
ولذلك، فإن نقد الأحكام القضائية الجائرة لا يعني تهديد الدولة أو تقويض النظام، بل هو شرط لاستمرار الثقة في القضاء. المجتمعات التي تتصالح مع نفسها، هي تلك التي تُراجع أحكامها، وتُعيد النظر في أخطائها، وتفسح المجال للرأي العام أن يسائل، ويسأل، ويُخطئ أحيانًا، لكنه لا يُصمت.
أما أن نختزل كل هذا في جملة “لا تعليق على الأحكام“، أو أن نُغلّف كل حكم – مهما كانت خلفياته – بهالة من القداسة، فذلك لا يحمي العدالة، بل يُجهز عليها باسم الوقار.
الحكم القضائي قد يكون نهاية للمحاكمة، لكنه لا يجب أن يكون نهاية للنقاش.
والاحترام الحقيقي للقضاء لا يعني أن نصمت، بل أن نُجادل حين نرى خطأ، وندافع حين نرى عدلًا، ونفرّق دائمًا بين ما هو قانوني وما هو عادل.
ففي بلاد تُقنّن فيها المظالم، لا يكفي أن يكون الحكم صادرًا باسم القانون… بل يجب أن يُقاس بما إذا كان قد صدر باسم الإنسان.
القاهرة في 17 يوليو 2025