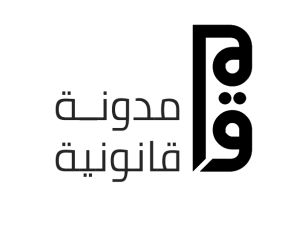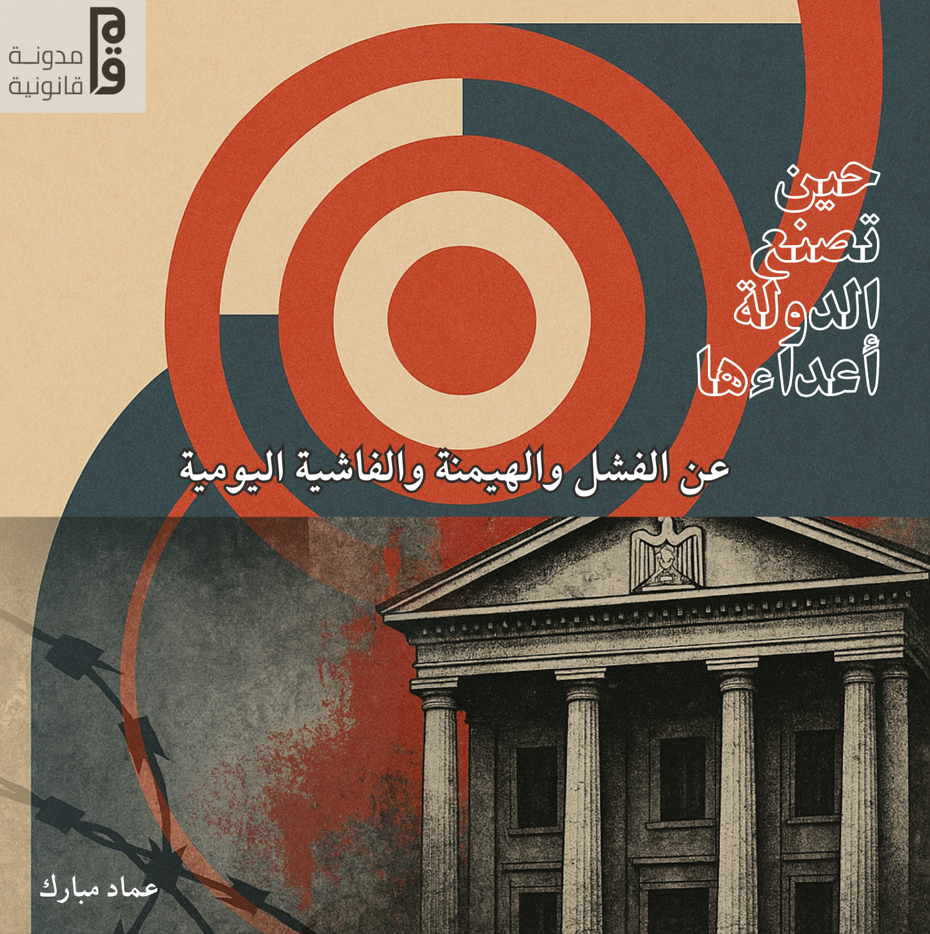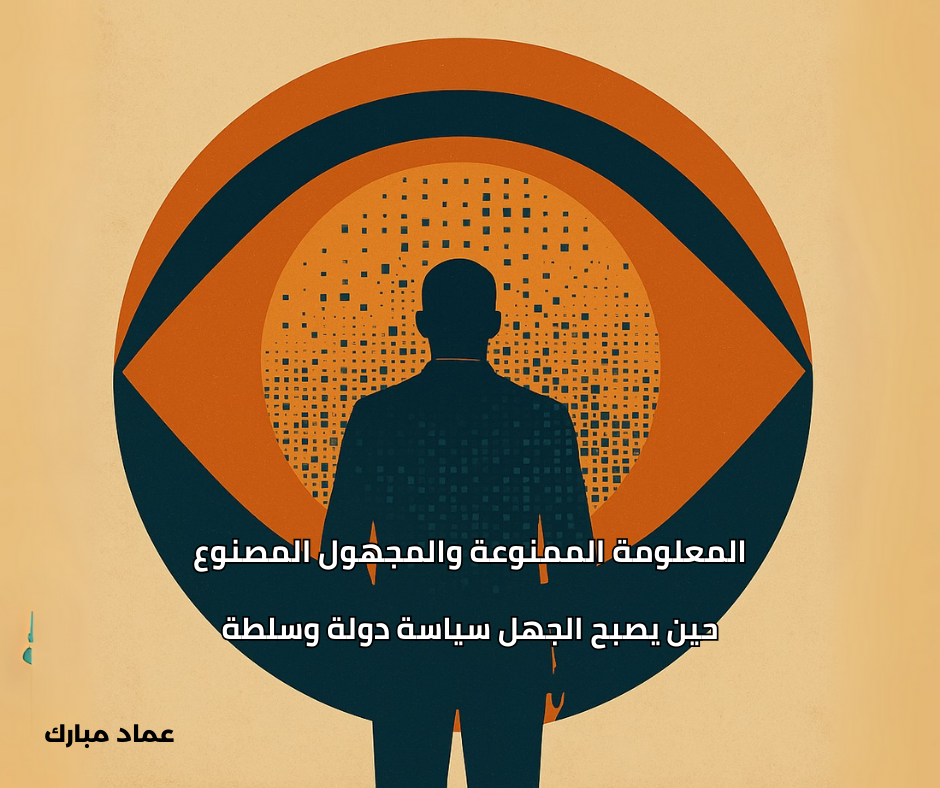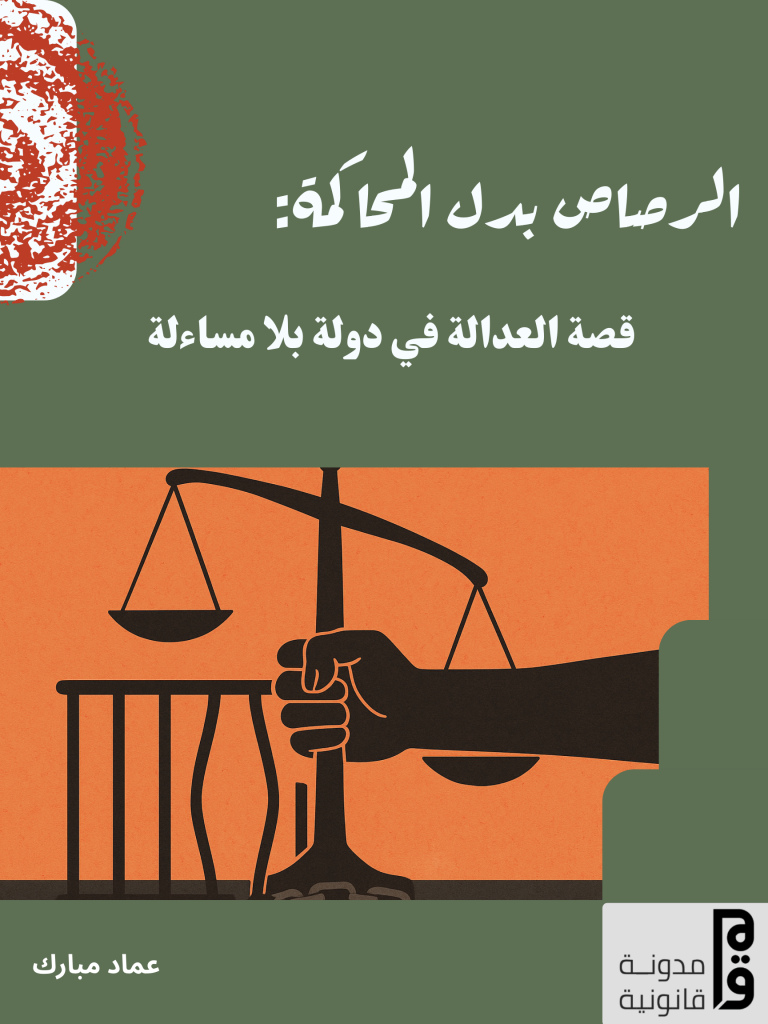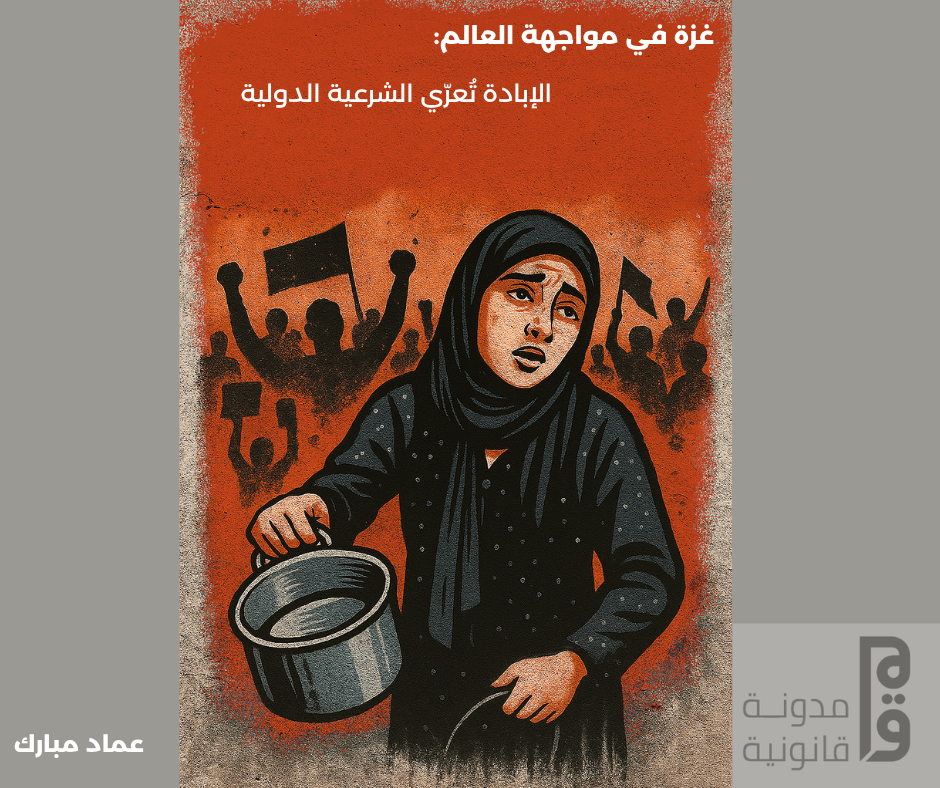في لحظة ما، لم يعد السؤال هو: لماذا تفشل الدولة في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس؟ بل صار: كيف تُعيد هذه الدولة تقديم فشلها باعتباره قدرًا لا مفر منه؟ أو أسوأ: كيف تُحمّل المجتمع نفسه مسؤولية فشلها؟
في النظم التي لا تملك مشروعًا اقتصاديًا يعيد توزيع الثروة، ولا رؤية سياسية تُنتج شرعية ديمقراطية، يتحوّل الحكم إلى معادلة أمنية خالصة. لكن الأمن، وحده، لا يكفي لتأبيد السلطة. فحتى أكثر أنظمة القمع كفاءة، تحتاج إلى ما يسندها ثقافيًا: تبرير أخلاقي، سردية خوف، عدو دائم، وشعور عام بأن كل فوضى منشأها المجتمع، لا الدولة.
وهنا يظهر التوجّه الفاشي، لا كمصطلح ثقافي مستهلك، بل كآلية حكم يومية: إقناع الناس بأن الانحرافات الأخلاقية تهديد أخطر من الفقر، وأن “الحفاظ على القيم” أهم من العدالة، وأن التمرد خطر خارجي لا داخلي، وأن الدولة تحارب لا من أجل السيطرة بل من أجل “الاستقرار“.
بهذا المنطق، يصبح مبررًا أن تُلاحَق فتاة فقيرة لأن رقصتها على تيك توك “تهدد الأسرة“، ويُزجّ بآلاف في السجون بتهمة “الانتماء” رغم مرور سنوات على تفكّك التنظيم، وانحسار أعضائه بين السجن والمنفى والمقابر. تصبح ثورة يناير خطيئة وطنية لا لحظة أمل، ويتحوّل الحديث عن الحقوق إلى خيانة، والنقد إلى مؤامرة. ليس لأن المجتمع طالب بهذا، بل لأن السلطة اختارت أن تُنتج هذا الخطاب لتبرير وجودها.
المفارقة أن الدولة التي تفشل في تقديم تعليم جيد، أو سكن لائق، أو أجر عادل، هي نفسها الدولة التي تُطالب المواطن بالولاء، وتُعاقبه إن لم يقدّمه. فبدلًا من مساءلة السلطة على إخفاقاتها البنيوية، يُعاد توجيه الغضب الشعبي إلى الداخل: إلى “الناس“، إلى “الجهل“، إلى “الأخلاق المنهارة“، إلى “الفلاحين” و“السلفيين” و“القطيع“. ويُصبح النقد فعلًا نخبويًا منزوع التأثير، عاجزًا عن كسر الحلقة لأنها باتت مغلقة: دولة تُنتج فشلها، ثم تُجرّم ضحاياه.
ليست هذه مجرد أعراض متفرقة، بل بنية متماسكة. خطاب إعلامي يُضخِّم منجزات شكلية بلا مضمون اجتماعي (الأضخم، الأطول، الأعظم)، أجهزة أمنية تُعيد تشكيل المجال العام، ومؤسسات تعليمية وقضائية تخضع لتدريبات عسكرية رمزية لإعادة تراتبية الولاء. كل ذلك لا يُعبّر عن طارئ، بل عن نمط حكم يريد السيطرة الكاملة دون تقديم أي بديل.
لفهم هذا التحوّل، نحتاج إلى تتبع كيف غيّرت السلطة موقع المجتمع من شريك إلى متّهم، وكيف أعادت ترتيب أولوياتها لتُخفي الفشل البنيوي خلف خطاب أخلاقي متضخم.
ففي هذا النموذج من الحكم، لا يُرى المجتمع ككتلة حية تستحق التمثيل أو المشاركة، بل كخطر يجب احتواؤه. المواطن لا يُعامل كفاعل سياسي، بل ككائن قابل للانفجار يجب تدجينه. المؤسسات التي يُفترض أن تكون منصات للتمثيل—كالنقابات، والجامعات، والإعلام—تحوّلت إلى آليات مراقبة أو قنوات دعاية أو مساحات منزوعة الفعل.
هذه ليست مجرد نظرة سلطوية فوقية، بل إعادة تعريف جذرية لماهية المجتمع. حيث تتحوّل كل طموحات التغيير إلى مشاريع مشبوهة، ويُعاد إنتاج الناس داخل قوالب: الطيب هو الساكت، الوفي هو الخاضع، المحترم هو المُطيع. وما لا ينسجم مع هذه القوالب يُدان لا باعتباره رأيًا مختلفًا، بل تهديدًا للتماسك، للأسرة، للأمن، للوطن.
أمام هذا العجز في تحقيق أي وعود ملموسة، لا تجد الدولة ما تفعله سوى تحويل السياسة إلى خطاب أخلاقي. تُصبح معايير “الصلاح” و“الانضباط” و“الأدب” هي أدوات التصنيف الجديدة. فلا يُقاس النجاح بكمّ فرص العمل، بل بكمّ المحتوى “المنضبط“. ولا تُقاس فعالية الدولة بقدرتها على حماية الفقراء، بل بقدرتها على منع “التسيّب” و“الابتذال“.
هذا الانزياح ليس بريئًا، بل يُمكّن الدولة من إعادة ترتيب أولوياتها بحيث لا تُحاسب على ما لا تقدّمه، بل تُكافأ على ما تقمَعه. ومن هنا يُعاد تعريف الأزمة لا بوصفها غياب العدالة، بل غياب الحياء. وتُصبح المعركة الكبرى ليست ضد الفساد أو التفاوت، بل ضد فيديو على تيك توك أو جملة في منشور.
وحين تفقد السلطة قدرتها على بناء شرعية نابعة من التمثيل أو الإنجاز، تبدأ في إنتاج “فاشية اجتماعية” عبر قنوات التفاف جماعي حول الخوف. لا تدير السلطة وحدها هذا الخوف، بل تُعيد إنتاجه عبر المجتمع نفسه: إعلاميون، فقهاء، نخب اقتصادية، أكاديميون. كلهم يتحوّلون إلى وسطاء يعيدون تدوير منطق السلطة بلغة أقرب إلى الناس، لكنها لا تقلّ عنفًا.
وهكذا، بدلًا من جهاز أيديولوجي واضح المعالم، يُعاد توزيع وظيفة الضبط على المجتمع نفسه. يُراقب الناس بعضهم بعضًا، ويُعاقَب المختلف لا فقط بيد الدولة، بل بنظرات الجيران وتهديدات الإدارة وباب الفصل في المدرسة.
في قلب هذه المنظومة السلطوية، لا يظهر الخطاب الرسمي كمجرد تبرير لتدخلات الدولة، بل كأداة لإعادة تعريف الواقع نفسه. هو خطاب لا يُخاطب العقل، بل الخوف. لا يُقدّم حججًا، بل يُطلق أحكامًا. وبمرور الوقت، يتحول هذا الخطاب إلى بوصلة مشوهة تُحدّد ما هو مقبول اجتماعيًا وسياسيًا، وتُقنع الناس بأن معركتهم ليست مع السلطة بل مع أنفسهم، مع جيرانهم، مع أولادهم، مع “الانحلال الأخلاقي” الذي تسلل فجأة إلى “قيم الأسرة“.
في هذا الخطاب، لا تُطرح الأزمة بوصفها خللًا في توزيع الموارد أو فشلًا في التخطيط، بل كتهديد أخلاقي: “القيم المصرية“، “الأسرة المصرية“، “الهوية الوطنية“… عبارات فضفاضة بلا تعريف، لكنها فعالة لأنها تبني عدوًا سهلاً: فتاة فقيرة ترقص، شاب يكتب منشورًا، محتوى ساخر، لهجة غير مألوفة.
وتتكرّر الصيغة:
-
كل من يعترض على غلاء الأسعار → مدفوع من الخارج
-
كل من يطالب بالعدالة الاجتماعية → يحقد على الأغنياء
-
كل من يختلف في التعبير أو الهيئة → يهدد القيم
هذا الخطاب لا يقتصر على تصريحات الوزراء والرؤساء، بل يُعاد إنتاجه عبر الإعلام، والمناهج، وخطب الجمعة، ومداخلات الأهالي في البرامج. كل شيء يُضبط على إيقاع واحد: لا صوت يعلو فوق صوت “الحفاظ على التماسك“، ولو على حساب الحقوق، العدالة، أو حتى العقل.
المفارقة أن هذه السلطة، التي تفشل في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، تملك فائضًا لغويًا أخلاقيًا لا ينضب. هي لا تتردد في فرض رقابتها على “الضمير الجمعي“، بينما تترك الناس فريسة للجوع والعشوائية والإهانة اليومية. وحين يُسأل المسؤول، لا يتحدث عن الحق، بل عن “الحياء“. لا يدافع عن الكرامة، بل عن “الصورة الحضارية“. وكأن الغاية من الحكم لم تعد تحقيق العدالة، بل الحفاظ على واجهة بصرية محافظة، تُخفي تحتها كلّ شيء.
وهكذا يُختزل دور الدولة من راعية للحقوق إلى وصيّ على السلوك. ومن ضامن للعدالة إلى حارس على الفضيلة. ويُصبح العقاب أداة أخلاقية، لا قانونية، يبرّر كل انتهاك بأنه “استجابة للرأي العام” أو “حماية لقيم المجتمع“.
لكن أي قيم هذه التي لا تحتمل صوتًا مختلفًا، أو هيئة غريبة، أو سلوكًا غير مألوف؟ وأي مجتمع هذا الذي يحتاج إلى قمع أبنائه كي يظل متماسكًا؟
الخطاب الرسمي هنا لا يُدير الواقع، بل يُزيّفه. يُبدّد الغضب في معارك وهمية، ويُقدّم التقييد كنوع من الحماية، والصمت كفضيلة، والانضباط كمصير.
وما لم يُكسر هذا الخطاب، ستبقى الدولة قادرة على أن تُدين الناس بما زرعته فيهم، وتُحاكم المجتمع على ما أنتجته سياساتها، وتُعيد تدوير الخوف ليحكم الجميع.
رغم كل أدوات القمع والسيطرة، تبقى الأرض من تحت النظام هشّة. آلة أمنية تعمل بكفاءة، إعلام موحّد الخطاب، وتشريعات تحاصر الفضاء العام؛ هذا كله لا يمنع تراكم الغضب، والإهانة، والشعور بالانسداد.
الغضب هنا لا يتشكّل في صورة ثورة كلاسيكية، ولا يتخذ شكلًا واحدًا. بل يظهر كفقاعات متفرقة: احتجاج على قانون إيجارات، صرخة من عجوز تريد أن تأكل، خبر عن حريق غامض في سنترال، همس عن مداهمة ليلية، سخط من استفزازات السلطة في “جمهورية الساحل“، انفعال مكبوت تجاه العدوان على غزة، استياء مكشوف من انتخابات لا تُقنع أحدًا. هذه ليست أحداثًا منفصلة، بل نُذر لزلزال مقبل.
كل فقاعة هي علامة على عطب في البنية. وكل تجاهل لهذه العلامات لا يُطيل عمر الاستقرار، بل يُراكم شروط انفجاره. لأن الغضب حين لا يجد مخرجًا سياسيًا أو اجتماعيًا، ينفجر في شكل لا يمكن التنبؤ به ولا احتواؤه.
تكرار التحذيرات من الانفجار القادم ليس تهويلًا، بل إعادة قراءة للتاريخ القريب. فمن تجاهل التحذيرات في ٢٠٠٩ و٢٠١٠، لم يتعلّم شيئًا، بل كرّر نفس المسار بتقنيات أكثر قسوة. ومع ذلك، فإن الإنكار لا يُبطِل الحقيقة، بل يُعمّي عنها مؤقتًا.
تبدو الدولة الآن كمن يضغط الغطاء فوق إناء يغلي. يُحكم إغلاقه أكثر، ثم أكثر، ويتخيّل أن الصمت علامة رضا. لكن البخار يتراكم، والحرارة ترتفع، والسطح يخدع. وعند نقطة معينة، لا يكون السؤال هل سينفجر، بل متى، وكيف، وأين.
وفي النهاية، لا يمكن لدولة أن تبني شرعيتها على إنكار فشلها أو تجريم مواطنيها. حين تتحول الدولة من حامية للحقوق إلى وصي على السلوك، ومن ضامن للعدالة إلى حارس على الفضيلة، فإنها لا تُطيل عمرها، بل تُؤجل فقط لحظة الحقيقة. إنّ الخروج من هذا المسار لا يكمن في مزيد من القمع، بل في إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع. دولة لا تخاف من النقد، ولا تحاكم الناس على تعابيرهم، ولا تُحمّلهم مسؤولية إخفاقاتها، هي وحدها القادرة على بناء مجتمع حقيقي، لا مجرد كتلة من الخاضعين. لأن السؤال الأهم لا يزال قائمًا: هل نريد دولة تُراكم القمع إلى أن ينفجر، أم دولة تُراكم الحقوق لتبني مجتمعًا؟