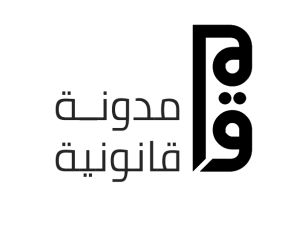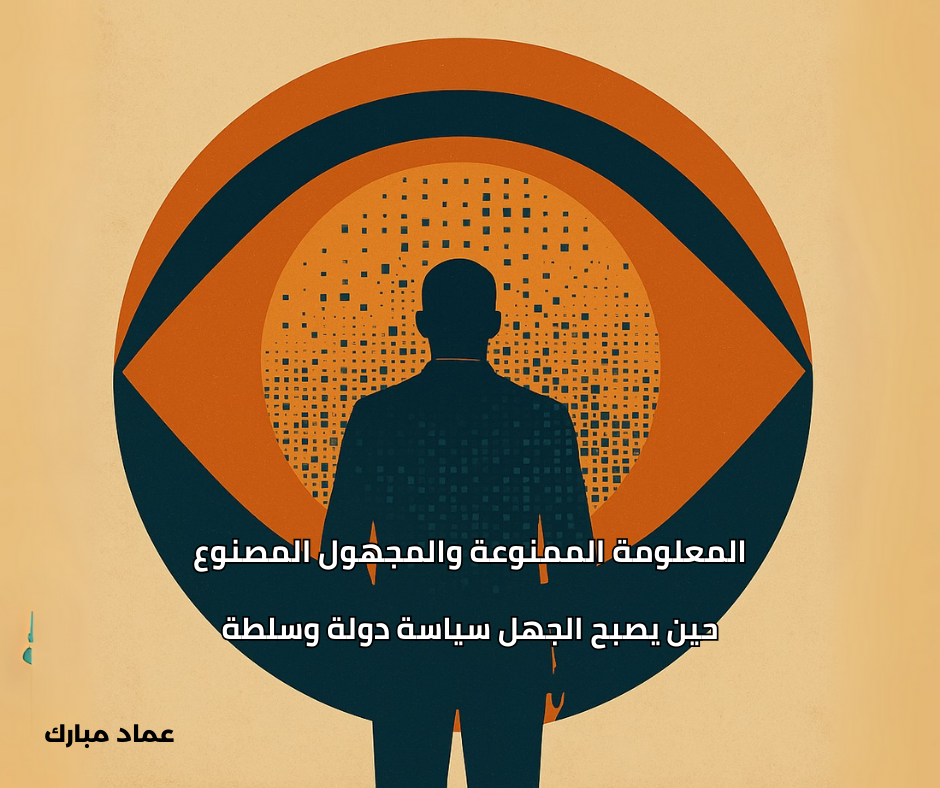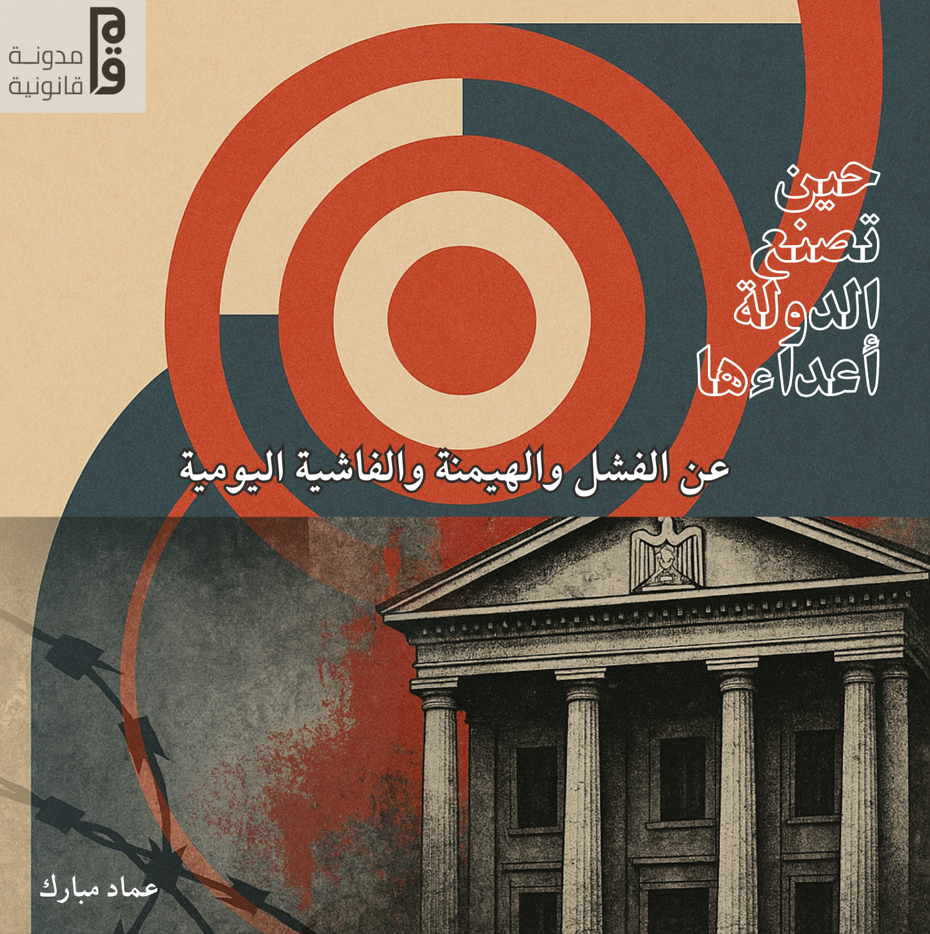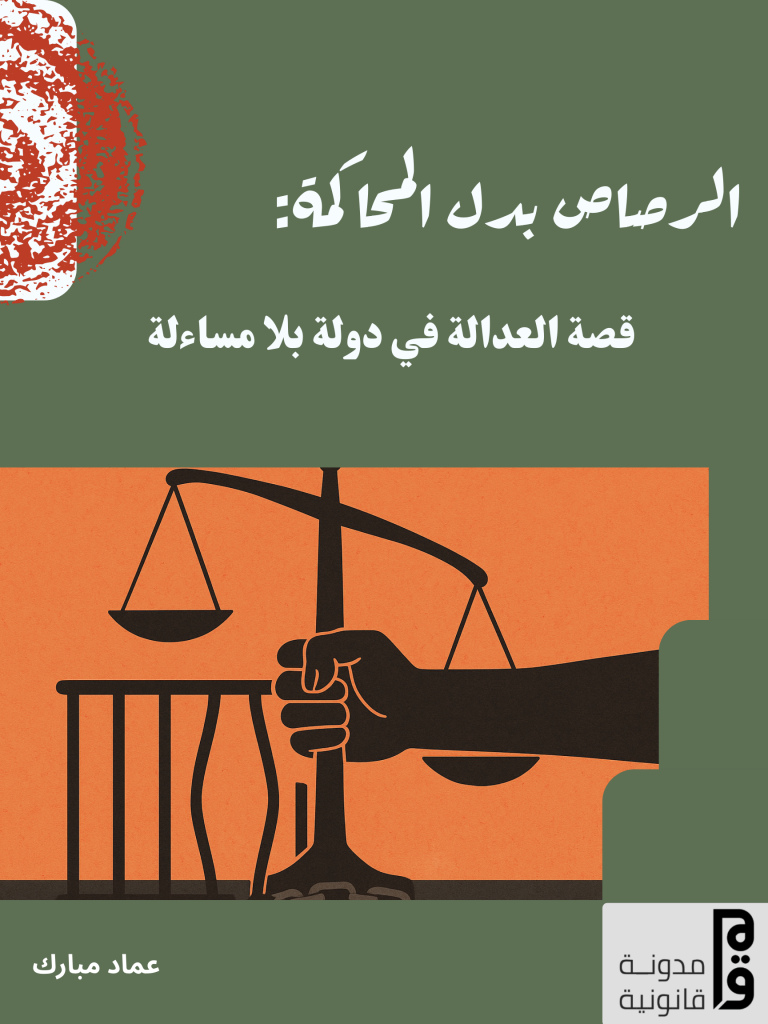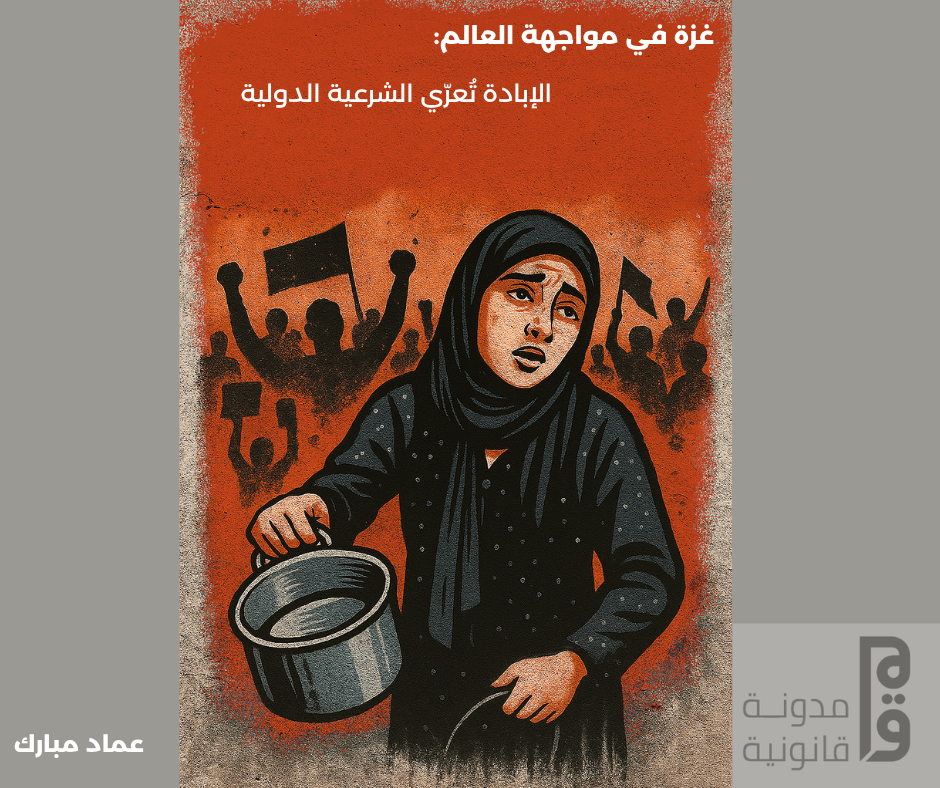في مصر، ليست المعلومة غائبة بحكم الصدفة أو بفعل قصور مؤسسي عارض، بل هي موضع صراع سياسي واجتماعي مستمر. من يتأمل علاقة الدولة بالبيانات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الصحية، يكتشف سريعًا أن ما يُعلن وما يُحجب ليس مسألة تقنية، بل قرار يُعاد إنتاجه يومًا بعد يوم. المعلومة تُعامل هنا باعتبارها سلعة احتكارية، تتحكم فيها الدولة وتُعيد توزيعها وفق ما يخدم صورتها أمام المجتمع وأمام العالم. ومع أن هذا النمط ممتد تاريخيًا، إلا أن ما يميّز اللحظة الراهنة هو أن السلطة الحالية دفعت به إلى أقصى درجات الحدة والشراسة. ففي مقابل وفرة الأرقام التي تُعلن على المنصات الرسمية عن معدلات النمو أو حجم الاستثمارات أو الإنجازات العمرانية، نجد ندرة في البيانات المتعلقة بالفقر، والبطالة، والصحة العامة، والتعليم، وهي المجالات التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة وتكشف حقيقة التفاوتات الاجتماعية.
غياب هذه المعلومة أو تأجيلها أو إعادة صياغتها ليس تفصيلًا إداريًا يمكن تجاوزه، بل هو اختيار سياسي مقصود. اختيار يعني أن الدولة لم ترَ في الحق في المعرفة جزءًا من العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين، بينما مع النظام الحالي تحوّل الأمر إلى أداة بيد السلطة لتكريس قبضتها وصورتها. ومن هنا فإن الحديث عن “الشفافية” لا يمكن أن ينفصل عن طبيعة الحكم نفسه، وعن الحدود التي تفرضها الدولة عبر مؤسساتها، والسلطة عبر أجهزتها، على ما يمكن أن يُعرف وما يجب أن يُجهل.
المعلومة كأداة سياسية وصناعة المجهول
الحجب في الحالة المصرية ليس فعلًا عارضًا، بل ممارسة مقصودة ترسّخ منطق السيطرة. فالمعلومة التي قد تمكّن المجتمع من قراءة أوضاعه أو محاسبة الحاكم تتحوّل إلى عبء يجب التخلص منه. لذلك تُدار البيانات بمنطق الإتاحة الانتقائية، حيث تُعلن الدولة ما يدعم صورتها، وتؤجل أو تُخفي ما يكشف تناقضاتها. ومع السلطة الحالية، صار هذا المنطق أكثر وضوحًا وقسوة. يتجلى ذلك بوضوح في تعامل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع بيانات الدخل والإنفاق التي تحدد بناءً عليها نسب الفقر الرسمية. ففي أكثر من مناسبة، جرى تأجيل نشر هذه البيانات أو إعادة صياغتها لتخفيف وقعها على الرأي العام. ليست المسألة هنا في الرقم المجرد، بل في أثره السياسي: فالإعلان عن ارتفاع نسب الفقر يقوّض سردية الإنجاز الاقتصادي، بينما تأجيل الرقم يمنح السلطة فرصة لإعادة ترتيب خطابها. الأمر نفسه ينطبق على مؤشرات البطالة والتضخم. تُقدَّم الأرقام بشكل دوري، لكنها بلا نقاش علني حول منهجيات جمعها أو معاييرها.
يمتد هذا النمط من التحكم ليشمل صناعة المجهول نفسه. فالجهل هنا ليس مجرد غياب للمعرفة، بل هو نتاج استراتيجية متعمدة لإنتاج إدراك ناقص. حين تُنشر بيانات مبتورة عن التضخم من دون تفاصيل السلع الأساسية، أو تُعلن نسب بطالة لا تحتسب الاقتصاد غير الرسمي، فإن النتيجة ليست “معلومة ناقصة” بل رواية زائفة تُعيد إنتاج الغموض. هذا الأمر يتكرر بوضوح في حوادث القطارات أو انهيارات المباني: تُعلن حصيلة أولية للضحايا ثم تُترك بلا تحديث، أو تتناقض المصادر في أرقامها. النتيجة أن الحقيقة تتبخر وسط الضباب، ويتحول الغموض نفسه إلى وسيلة لإعفاء المسؤولين من المحاسبة.
أخطر أبعاد هذه السياسة يتجلى في تزييف الذاكرة الجماعية. فـالدولة عبر تاريخها لم تسع فقط للسيطرة على الحاضر، بل حاولت إعادة كتابة الماضي. ومع السلطة الحالية، اكتسب هذا المسعى بعدًا أكثر شمولًا. يتم إبراز لحظات معينة من التاريخ تخدم سردية الحكم، بينما تُطمس حركات التمرد أو تُشوه سيرة شخصيات معارضة. الأرشيف الوطني، والمناهج التعليمية، وحتى أسماء الشوارع والميادين، تتحول إلى أدوات لقولبة الوعي وإعادة إنتاج “تاريخ رسمي” خاضع بالكامل للرواية السلطوية. وفي مقابل هذا الجهد، تبرز أهمية الأرشيف الرقمي المستقل ومبادرات توثيق التاريخ الشفوي، التي تحاول انتزاع الذاكرة من قبضة الدولة كجهاز مسيطر، ومن قبضة السلطة كفاعل حالي، وإعادتها إلى الأفراد والمجتمع. هذه المحاولات هي فعل مقاومة ضد محو الهوية الجمعية وتجريد المجتمع من ماضيه.
المعرفة كفعل مقاومة: صراع من أجل الوعي والمستقبل
في مواجهة هذه السياسة، يصبح إنتاج المعرفة فعلًا مقاومًا بذاته. جمع البيانات وتوثيق الانتهاكات ونشر الإحصاءات المستقلة ليست أعمالًا تقنية، بل محاولات لانتزاع الحقيقة من قبضة الدولة والسلطة. الرقم الذي يرصُد عدد المحبوسين احتياطيًا، أو التقرير الذي يكشف نسب الفقر، أو التحقيق الصحفي عن مأساة إنسانية، كلها محاولات لفتح ثغرة في جدار السيطرة. المنظمات الحقوقية والصحافة المستقلة لعبت هذا الدور رغم ضعف الموارد والملاحقة المستمرة. فهي لا تكتفي بوصف الواقع، بل تعيد صياغته من منظور يفضح تناقض الرواية الرسمية. وجود هذه المحاولات – مهما كانت محدودة – يؤكد أن الحق في المعلومة لا يمكن مصادرته بالكامل.
لكن يبقى السؤال: هل تكفي المعرفة وحدها لتغيير المعادلة؟ التجربة المصرية تكشف أن المعرفة، مهما بلغت دقتها، لا تتحول تلقائيًا إلى قوة سياسية. ففي غياب مؤسسات قادرة على تحويل البيانات إلى مساءلة – برلمان مستقل، صحافة حرة، أحزاب فاعلة – تبقى المعلومة مثل نصّ غير مقروء: موجودة، لكنها عاجزة عن أن تنتج أثرًا في المجال العام. ومع ذلك، يظل إنتاج المعرفة شرطًا لا غنى عنه. فـالدولة تستمد قوتها من احتكار البنية المؤسسية للرواية، والسلطة تضاعف هذا الاحتكار وتديره بمنطق أمني أكثر قسوة. كسر هذا الاحتكار – حتى جزئيًا – يُحدث شرخًا في جدار السيطرة، ويمنح مساحات صغيرة للنقاش قد لا تغيّر السياسات فورًا لكنها تراكم خطابًا بديلًا يمكن البناء عليه. المعرفة إذن ليست كافية، لكنها ضرورية. من دونها لا يبقى سوى الجهل المصنوع، ومعها يُفتح باب، ولو ضيق، لتخيّل مستقبل مختلف.
في هذا السياق، يصبح الجهل سياسة يومية، وتتحول المعرفة إلى مقاومة. صحيح أن هذه المقاومة لا تكفي وحدها لإحداث تغيير جذري، لكنها تظل الشرط الأول لأي مساءلة حقيقية وأي أفق مختلف. فالمجتمع الذي يُحرم من المعلومة يُحرم من الحق في أن يشارك في تعريف واقعه، بينما المجتمع الذي ينتزع المعرفة، ولو جزئيًا، يخطو أولى خطواته نحو استعادة السياسة من قبضة الجهل المصنوع. إن المعركة الحالية ليست مجرد صراع على الأرقام، بل هي صراع على المعنى نفسه. على معنى الفقر والبطالة، ومعنى الإنجاز والفشل، ومعنى الماضي والمستقبل. ولهذا، فإن كل معلومة يتم استعادتها من قبضة الدولة كمؤسسة ممتدة، ومن قبضة السلطة كفاعل مباشر، وكل تقرير مستقل يتم نشره، وكل حقيقة يتم توثيقها، هي خطوة صغيرة في معركة طويلة، لا تهدف فقط إلى كشف ما هو مخفي، بل إلى إعادة بناء الثقة في قدرة المجتمع على رؤية واقعه بعينيه، واستعادة حقه في تحديد مصيره.