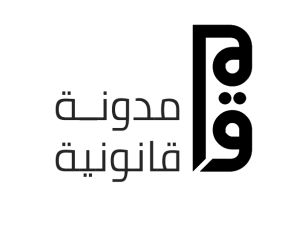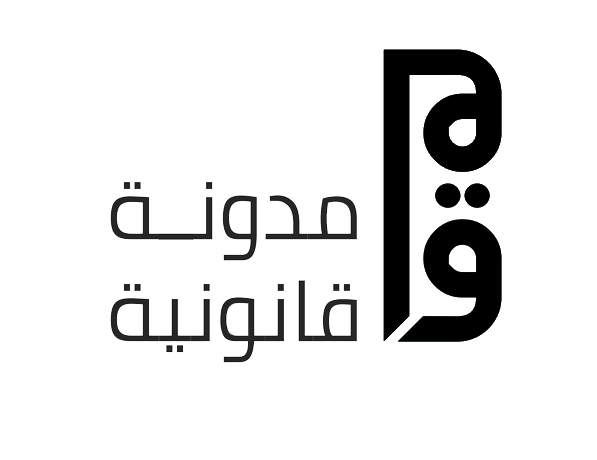يناير لم تكن ميدانًا فقط: عن الغضب الاجتماعي الذي سبق السياسة
حين نستعيد 25 يناير اليوم، كثيرًا ما تبدأ الذاكرة من الميدان: من الحشود، والهتافات، والمواجهات، وصور الشباب وهم يرفعون شعارات الحرية والكرامة. لكن هذا الاستدعاء البصري السريع يخفي ما هو أعمق وأثقل: أن يناير لم تولد في الميادين، بل سبقتها سنوات طويلة من الغضب الاجتماعي الصامت، ومن الاحتجاجات المتفرقة، ومن التآكل البطيء في شروط الحياة.
قبل 2011 بسنوات، كانت المصانع قد بدأت تتكلم. إضرابات المحلة الكبرى، احتجاجات عمال الضرائب العقارية، تحركات النقل العام، واعتصامات موظفي الدولة، كلها كانت إشارات مبكرة إلى أزمة تتجاوز السياسة بمعناها الضيق. كان هناك شعور متنامٍ بأن العقد الاجتماعي الذي حكم العلاقة بين الدولة والمجتمع منذ الخمسينيات قد انهار فعليًا، وأن السياسات النيوليبرالية التي تسارعت منذ التسعينيات أعادت توزيع الخسائر على الفئات الأضعف، بينما راكمت الامتيازات في قمة هرم ضيق.
لم يكن هذا مجرد تدهور اقتصادي، بل تحوّل في شكل العيش نفسه. اتسعت الفجوة بين الدخول، تآكلت الطبقة الوسطى، صارت الوظائف أكثر هشاشة، وتراجعت قدرة الأسر على التخطيط للمستقبل. المدن تمددت بلا خدمات، والريف فقد جزءًا كبيرًا من قدرته على الإعاشة، ومع كل ذلك ظل المجال العام مغلقًا، والتمثيل السياسي شكليًا، والقمع حاضرًا في التفاصيل اليومية.
في هذا السياق، جاءت يناير كتقاطع نادر بين غضب اجتماعي متراكم وشرارة سياسية فجّرت المكبوت. لم تكن “ثورة شباب”، بل لحظة التقت فيها مطالب الخبز مع مطالب الحرية، وتجاور فيها العامل والطالب والموظف وصاحب المهنة الحرة. ما حدث في الأيام الأولى كان خروجًا جماعيًا من حالة الصمت، لا تعبيرًا عن مشروع سياسي مكتمل.
لكن هذا البعد الاجتماعي سرعان ما جرى تهميشه في السرديات اللاحقة.
من الغضب إلى الملف: كيف عُزلت يناير عن جذورها
بعد الأيام الأولى، بدأ مسار مختلف يتشكّل حول يناير. لم يعد السؤال يدور حول أسباب الغضب الاجتماعي ولا حول شروط الحياة التي دفعت الملايين إلى الشارع، بل حول من يتحدث باسم الثورة، ومن يدير المرحلة الانتقالية، وكيف تُعاد صياغة السلطة سياسيًا. انتقلت اللحظة بسرعة من المجال الاجتماعي المفتوح إلى مساحة سياسية ضيقة، تُدار عبر التفاوض، والبيانات، وغرف مغلقة.
في هذا الانتقال، جرى اختزال حدث واسع ومعقّد في سردية مبسطة: شباب في مواجهة نظام، نشطاء يطالبون بالديمقراطية، وصراع يدور أساسًا حول الدستور والانتخابات. لم يكن هذا مجرد تبسيط إعلامي، بل إعادة تشكيل كاملة لطبيعة الصراع. تحوّلت يناير من انفجار اجتماعي واسع إلى أزمة سياسية إجرائية، ومن حركة ممتدة في الشوارع وأماكن العمل إلى ملف قابل للإدارة.
بالتوازي، تراجع حضور المطالب المرتبطة بالأجور، والعمل، والسكن، والخدمات العامة، بينما تصدرت المشهد نقاشات حول الشرعية الانتخابية وترتيبات الحكم. انفصلت الحرية عن العدالة الاجتماعية، وصارت السياسة تُمارس بمعزل عن شروط العيش. ومع هذا الفصل، فقدت يناير قاعدتها الأوسع، وبقيت محمولة على أكتاف مجموعات محدودة، يسهل محاصرتها وتشويهها.
لعب الإعلام دورًا مركزيًا في هذا التحول. جرى التركيز على الوجوه الفردية، وعلى لحظات المواجهة، وعلى الصراعات بين القوى السياسية، بينما غاب الحديث عن البنية الاجتماعية التي أنتجت الغضب من الأساس. ومع الوقت، ترسخت صورة يناير بوصفها حركة نخبوية أو مغامرة شبابية، لا بوصفها تعبيرًا عن أزمة مجتمعية عميقة.
هذا العزل لم يكن فقط نتيجة أخطاء ذاتية داخل الحركة، بل جزءًا من مسار أوسع لإعادة احتواء الحدث. حين تُختصر الثورة في نشطاء، يمكن اتهامهم أو تخوينهم. وحين تُفصل السياسة عن المجتمع، يصبح من الممكن إدارة الصراع داخل دوائر مغلقة، بعيدًا عن الناس.
ولم يكن هذا التحول مجرد نتيجة إنهاك الحركة، بل أيضًا نتيجة اختزال المعركة في رأس النظام، والتعامل مع ما جرى بوصفه انتقالًا سياسيًا، لا أزمة بنيوية في علاقة الدولة بالمجتمع. سقطت القمة، بينما بقيت البنية التي أنتجت الغضب قائمة، تعيد تنظيم نفسها في الخلفية.
هكذا جرى تفريغ يناير تدريجيًا من مضمونها الاجتماعي، وترك الاحتجاج بلا سند واسع، في وقت كانت فيه منظومة الحكم تستعيد توازنها وتعيد ترتيب أدواتها. لم يكن ما حدث مجرد تراجع في الزخم، بل تحوّل في طبيعة الصراع نفسه: من أزمة مجتمعية إلى إدارة ملف سياسي، ومن سؤال العدالة إلى حسابات الشرعية، ومن غضب جماعي إلى نشاط محاصر.
بهذه الحركة، بدأت يناير تفقد قدرتها على إرباك السلطة، وتتحول إلى عبء على من تبقّى متمسكين بها.
لحظة بلا مسار: التنظيم الغائب وحدود الفعل العفوي
إذا كانت يناير قد كشفت هشاشة منظومة الحكم، فقد كشفت في الوقت نفسه هشاشة قدرتنا على تحويل الغضب إلى قوة اجتماعية منظمة. ما حدث في الشارع كان واسعًا ومبهرًا، لكن ما غاب هو البنية القادرة على حماية هذا الزخم وتحويله إلى مسار طويل النفس. لم تتكوّن وسائط مستقرة تربط بين السياسة والحياة اليومية، ولا بين الاحتجاج ومواقع العمل والسكن.
ظل الفعل السياسي معلقًا في اللحظة. بيانات تُكتب، حملات تُطلق، مظاهرات تُنظم، لكن من دون تراكم تنظيمي حقيقي. لم تُبنَ شبكات قاعدية قادرة على الصمود، ولم تتشكل أدوات تمثيل اجتماعي تعبّر عن المصالح المادية للناس. ومع غياب هذه البنية، جرى استنزاف الشجاعة الفردية بسرعة، وتحوّلت المشاركة السياسية إلى مخاطرة شخصية عالية الكلفة.
هذا الغياب لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تاريخ طويل من تفكيك التنظيمات المستقلة، وتجريف المجال العام، وتدمير أي تقاليد للعمل الجماعي. دخلنا يناير بلا ذاكرة تنظيمية كافية، وبلا خبرة مؤسسية تسمح بإدارة الصراع على مدى سنوات. راهن كثيرون على اللحظة الكبرى، وعلى قدرة الحشود وحدها على فرض التغيير، من دون استعداد لمعركة ممتدة مع دولة تمتلك أجهزة وقوانين وموارد.
ومع أول موجات الرد، ظهر الفارق في ميزان القوة. كانت منظومة الحكم تعمل بالصبر والتراكم، بينما كانت الحركة السياسية تعمل بالإيقاع السريع والانفعال. ومع كل تراجع، كانت مساحة الفعل تضيق، ويزداد الاعتماد على مبادرات فردية معزولة، في وقت كانت فيه الأجهزة تعيد بناء قدرتها على الضبط والسيطرة.
بهذا المعنى، لم تكن الهزيمة نتيجة القمع فقط، بل نتيجة غياب التنظيم القادر على امتصاص الصدمات، وإعادة تجميع الصفوف، وربط المطالب السياسية بالقاعدة الاجتماعية الأوسع. تحوّل الاحتجاج إلى استنزاف، وتبددت الطاقة التي فجّرت اللحظة الأولى، لأن السياسة بقيت بلا حامل اجتماعي مستقر.
المعارضة والنخب: إدارة اللحظة بدل بناء البديل
انشغل كثيرون بإدارة المرحلة الانتقالية: من يشارك في الانتخابات، من يكتب الدستور، ومن يفاوض من. تركز النقاش حول الشرعية الإجرائية، بينما بقيت أسئلة السلطة الفعلية خارج الحساب. لم يُطرح تصور واضح لكيفية تفكيك منظومة السيطرة القائمة، ولا لبناء قواعد اجتماعية تحمي أي مكسب سياسي. تحولت السياسة إلى صراع على المواقع، لا إلى مشروع لإعادة تركيب العلاقة بين المجتمع والدولة.
زاد من هذا الخلل انفصال قطاعات واسعة من المعارضة عن شروط العيش اليومية للناس. بقي الخطاب السياسي حبيس قاعات مغلقة ومنصات إعلامية، بعيدًا عن أماكن العمل والأحياء. لم تُبذل جهود جدية لربط مطالب الحرية بأسئلة الأجور والسكن والخدمات العامة. ومع هذا الانفصال، فقدت المعارضة قدرتها على تمثيل غضب اجتماعي واسع، وتحولت تدريجيًا إلى فاعل محدود التأثير.
في الوقت نفسه، أضعفت الانقسامات الداخلية أي محاولة لبناء جبهة عريضة. سرعان ما تحولت الاختلافات السياسية إلى صراعات وجودية، وتقدمت الحسابات الفئوية على التفكير في المسار الطويل. ومع غياب تقاليد ديمقراطية راسخة داخل الكيانات المعارضة نفسها، أصبح من الصعب إدارة الخلافات أو إنتاج قيادة جماعية.
بهذا المعنى، لم يكن التراجع نتيجة تفوق السلطة وحده، بل أيضًا نتيجة عجز المعارضة عن الانتقال من منطق اللحظة إلى منطق البناء. وبينما كانت منظومة الحكم تعيد ترتيب أدواتها بهدوء، كانت القوى السياسية تستهلك طاقتها في معارك قصيرة النفس، بلا استراتيجية واضحة ولا أفق اجتماعي.
كيف أعادت منظومة الحكم بناء نفسها؟ القانون والاقتصاد كأدوات سيطرة
بعد مرحلة الارتباك التي أعقبت يناير، بدأ مسار واضح لإعادة تثبيت منظومة الحكم. لم يعتمد هذا المسار على القمع المباشر وحده، بل على إعادة توظيف القانون والاقتصاد معًا. جرى توسيع الإطار التشريعي بما يسمح بتجريم طيف واسع من أشكال الفعل العام، وتثبيت الحبس الاحتياطي كأداة إدارة سياسية، وخلق مسارات قضائية استثنائية تتيح للسلطة التحرك خارج أي رقابة فعلية. لم يعد القانون مجرد منظّم للمجال العام، بل صار جزءًا من منظومة إنتاج الخوف والانضباط.
في الوقت نفسه، أُعيد ترتيب الاقتصاد السياسي على نحو يعمّق السيطرة. توسّع الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والسلع الأساسية، مع منح امتيازات واسعة خارج منطق المنافسة أو المساءلة. تزامن ذلك مع إعادة تشكيل بيئة الاستثمار لصالح تحالف ضيق من رجال الأعمال المرتبطين بمراكز القرار، ومع تراجع واضح لدور الدولة الاجتماعي.
لم يكن هذا التحول اقتصاديًا فحسب، بل سياسيًا بامتياز. فمع تصاعد الديون، وتآكل الأجور، وارتفاع كلفة المعيشة، جرى تحميل المجتمع عبء السياسات الجديدة، بينما أُغلقت مساحات الاعتراض. صار القبول بالأمر الواقع شرطًا يوميًا للبقاء، وتحولت الحياة اليومية نفسها إلى مساحة ضغط مستمر: عمل هش، سكن غير آمن، وخوف دائم من السقوط الطبقي.
بهذا المعنى، لم تعد السيطرة تُمارس فقط عبر الأجهزة الأمنية، بل عبر الاقتصاد ذاته. القرارات المالية والنقدية صارت تُتخذ في دوائر مغلقة، وتُقدَّم للجمهور باعتبارها “ضرورات وطنية”، بينما يُطلب من الناس التكيّف معها بصمت. هكذا جرى تثبيت نموذج حكم يجمع بين قمع مؤسسي واسع، واقتصاد يعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية، ويحوّل الاحتجاج إلى مخاطرة وجودية.
ماذا كشفت يناير عنّا نحن؟
لم تكشف يناير فقط طبيعة النظام، بل كشفت حدود قدرتنا نحن على التنظيم، وعلى بناء بديل، وعلى تحمّل مسار طويل. أظهرت هشاشة الوسائط بين السياسة والمجتمع، وضعف التقاليد التنظيمية، وسهولة الانقسام عند أول اختبار. كشفت أن الغضب متوفر، لكن أدوات تحويله إلى قوة اجتماعية مستدامة شبه غائبة، وأن الجرأة الفردية، مهما بلغت، لا تعوّض غياب البنية الجماعية.
دخل كثيرون اللحظة بلا تصور واضح عن الدولة، ولا عن الاقتصاد، ولا عن معنى السلطة خارج القصر الرئاسي. راهنّا على سقوط الرأس، ولم نستعد لمعركة البنية. احتفلنا بالمساحة المفتوحة، ولم نبنِ مؤسسات تحميها. وحين بدأ الرد، وجدنا أنفسنا مكشوفين إلى حد بعيد.
كشفت يناير أيضًا هشاشة الروابط الاجتماعية التي كان يمكن أن تحمل مشروع التغيير. لم تكن الانقسامات السياسية وحدها هي المشكلة، بل ضعف الثقة المتبادلة، وتآكل أشكال التضامن، وانتشار وهم النجاة الفردية. ومع تصاعد القمع، انسحب كثيرون إلى دوائرهم الضيقة، لا لأنهم جبناء، بل لأن كلفة الفعل الجماعي صارت أعلى من قدرة الأفراد على الاحتمال.
في هذا السياق، تحولت السياسة إلى عبء وجودي. لم تعد مساحة أمل، بل مصدر خطر دائم. ومع غياب أفق واضح، صار البقاء نفسه مشروعًا يوميًا. هذا ليس اتهامًا لأحد، بل توصيف لواقع أعاد تشكيل علاقتنا بالفعل العام، وحاصر الخيال السياسي داخل حدود ضيقة.
ماذا تعلّمنا؟ يناير كمعرفة لا كذكرى
ربما كان أهم ما تركته يناير هو هذه المعرفة القاسية التي لا يمكن القفز فوقها. علّمتنا أن الغضب وحده لا يصنع تغييرًا، وأن الحشود، مهما بلغت كثافتها، لا تعوّض غياب التنظيم. كشفت أن إسقاط رأس النظام لا يعني تفكيك بنية السلطة، وأن السياسة لا تُبنى في الميادين فقط، بل في أماكن العمل، والأحياء، والنقابات، وفي التفاصيل اليومية للحياة.
علّمتنا أيضًا أن الحرية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن أي مشروع تغيير يتجاهل شروط العيش المادي للناس يظل هشًا وقابلًا للاحتواء. كشفت حدود الفعل العفوي، وأهمية التراكم البطيء، وخطورة الرهان على اللحظة الكبرى. الأهم أنها أسقطت أوهام الإصلاح من الداخل، وفضحت العلاقة العضوية بين القمع والاقتصاد، بين السيطرة السياسية وإعادة توزيع الخسائر على المجتمع.
هذه ليست دروسًا نظرية، بل خبرة مدفوعة الثمن. خبرة كُتبت في أجساد المعتقلين، وفي أعمار ضاعت، وفي مسارات حياة انقطعت. ومع ذلك، فهي معرفة قابلة للبناء عليها، إذا جرى التعامل معها بوصفها أساسًا لأي اشتباك قادم، لا مجرد سردية عن الهزيمة.
يناير أعادت السياسة إلى حياة جيل كامل، حتى وإن انتهت التجربة بانكسار. جعلت آلاف الناس يرون الدولة على حقيقتها، ويدركون حدود الممكن، ويختبرون معنى الاعتراض. هذا الوعي لا يُمحى بسهولة، حتى في أكثر لحظات الانغلاق.
الاشتباك اليوم: من الذكرى إلى الفعل
بعد خمسة عشر عامًا، لا يبدو استدعاء يناير فعل حنين، ولا مناسبة للاحتفال، بل لحظة مراجعة. ما تبقّى من تلك التجربة ليس صور الميدان، بل الأسئلة الثقيلة التي تركتها وراءها: كيف نبني قوة اجتماعية قادرة على الاستمرار؟ كيف نعيد وصل السياسة بحياة الناس اليومية؟ وكيف نشتبك مع منظومة حكم لا تعتمد على القمع وحده، بل على إعادة تشكيل شروط العيش نفسها؟
الاشتباك اليوم لا يعني انتظار انفجار جديد، ولا التعويل على لحظة استثنائية أخرى. يعني العمل داخل الواقع القائم، بتراكم بطيء وصبور: بناء شبكات تضامن، ومساحات تنظيم قاعدي، ومعرفة جماعية تربط بين الحرية والعدالة الاجتماعية، بين الاعتراض والخبز، بين السياسة والعمل. يعني إعادة التفكير في أدواتنا، وفي لغتنا، وفي علاقتنا بالمجتمع، بدل الاكتفاء بإدارة الغضب أو التعبير عنه.
ربما لا نملك ترف التفاؤل في هذا السياق، لكننا نملك شيئًا أثمن: تجربة مدفوعة الثمن، ووعيًا بأن التغيير مسار طويل لا لحظة خاطفة. يناير لم تمنحنا طريقًا جاهزًا، لكنها كشفت حدود الطرق القديمة، وفتحت سؤال التنظيم بوصفه شرط أي أفق.
هذا هو المعنى المتبقي من يناير اليوم: ليس ذكرى تُستعاد، بل معرفة تُختبر كل يوم، ومسؤولية مستمرة تجاه ما لم يُنجز بعد، وما لن يُنجز من تلقاء نفسه.